انقلاب الأردن.. – حسني محلي
انقلاب الأردن.. ماذا بين آل سعود وآل هاشم؟
التاريخ مليء بالقصص المثيرة في العلاقة بين العائلتين التي تلاعبت بهما بريطانيا كما شاءت، ومتى أرادت، تارة ضد الدولة العثمانية، وتارة أخرى ضد بعضهما البعض.
لقد قيل وكُتِب الكثير عن احتمالات أن تكون الرياض خلف “محاولة الانقلاب الفاشلة” ضد العاهل الأردني الملك عبد الله، الذي رفض استقبال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال زيارته الخاطفة لعمان، وكان الهدف منها إنقاذ باسم عوض الله، الذي قيل إنه متورط في المحاولة الفاشلة.
عوض الله هو مواطن أردني ومستشار سابق للملك عبد الله، شغل قبل اعتقاله منصب المبعوث الخاص للملك الأردني إلى المملكة العربية السعودية، التي منحته الجنسية السعودية بعد أن بات مقرباً جداً إلى ولي العهد محمد بن سلمان، ويعدّ سجله أسود في موضوع جمال خاشقجي وملفات أخرى.
ومن دون الدخول في تفاصيل هذه المحاولة الفاشلة ودور السعودية المحتمل فيها ومبرراتها وخلفياتها المثيرة، لا بد من التذكير بالعداء التاريخي بين آل سعود وآل هاشم، وهما معاً “صناعة بريطانية أصلية”، فقد نجح عملاء بريطانيا من أمثال لورانس وكوكس وبيل في اكتشاف هذه العوائل وأمثالها في منطقة الخليج خلال الحكم العثماني للمنطقة التي شهدت ميلاد العديد من الـ”آل” التي ما زالت تحكم دويلاتها منذ أكثر من مئة عام، بوصاية بريطانية، والآن أميركية.
عودة إلى آل سعود وآل هاشم، باعتبار أنهما من التربة نفسها، فالتاريخ مليء بالعديد من القصص المثيرة في العلاقة بين العائلتين التي تلاعبت بهما بريطانيا كما شاءت، ومتى أرادت، تارة ضد الدولة العثمانية، وتارة أخرى ضد بعضهما البعض، وهو ما فعلته الدولة العثمانية التي تحالفت مع آل هاشم ضد آل سعود، الذين تمردوا عليها منذ أواخر القرن السابع عشر، إلى أن استطاع إبراهيم باشا نجل محمد علي باشا، حاكم مصر، القضاء على هذا التمرد.
وقد أسر إبراهيم باشا زعيم المتمردين عبد الله بن سعود والعديد من أفراد عائلته، وتم اقتيادهم إلى إسطنبول، فأمر السلطان محمود الثاني بقطع رأسه في شباط/فبراير 1820. وقد يكون قطع رأس جمال خاشقجي بأمر من محمد بن سلمان بمثابة انتقام من آل سعود من الأتراك، باعتبار أنه مقرّب إلى إردوغان، ومكان الحادثة إسطنبول؛ عاصمة الدولة العثمانية.
لقد كان مقتل الأمير عبد الله، وما زال، السبب الرئيسي في عداء آل سعود لتركيا والأتراك والعثمانيين، على الرغم من مراحل التحالف التكتيكي بينهما في فترات مختلفة، وآخرها سنوات “الربيع العربي”، عندما تحالف الجميع في سوريا، ومعهم آل هاشم. وقد نفى الإنكليز ملكهم طلال بشكل مقصود إلى إسطنبول (التي تمرد عليها جده الشريف حسين)، بحجة أنه “مختلّ عقلياً”، بعد أن أزعجهم بتصرفاته “القومية” عندما أصبح ملكاً للأردن لعام واحد فقط بعد مقتل والده الملك عبد الله.
لم يكن الانتصار العثماني على آل سعود كافياً للقضاء على هذه العائلة التي أعادت لمّ شملها بدعم بريطاني وتبنت العائلة المذهب الوهابي كنهج عقائدي في المنطقة عموماً. وعاد عملاء بريطانيا إلى تكتيكاتهم التقليدية في الاستفادة من إمكانيات آل سعود وآل هاشم معاً ضد السلطان العثماني، الذي اضطر في العام 1908، بناءً على طلب حكومة الاتحاد والترقي الماسونية، إلى تعيين الشريف حسين أميراً على مكة، بعد أن كان مقيماً في إسطنبول التي ولد فيها في العام 1853، وعاش فيها للفترة الممتدة من العام 1892 وحتى موعد مغادرته لها، حيث كان عضواً في مجلس الأعيان (البرلمان العثماني).
ولم يهمل السلطان علاقاته مع آل الرشيد كصمام أمان للتصدي لمحاولات الشريف حسين، بعد المعلومات التي بدأت تتحدث عن اتصالات سرية بينه وبين بريطانيا التي كانت تخطط لمحاصرة القوات العثمانية في المنطقة العربية. وقد اكتسبت هذه المعلومات طابعاً جدياً بعد أن رفض الشريف حسين دعوة السلطان محمد رشاد الخامس في 15 كانون الثاني/يناير 1915 لإعلان الجهاد دعماً للدولة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.
وانتهى هذا الفتور والتوتر بين الطرفين بإعلان الشريف حسين آل هاشم الثورة العربية بقيادة الجنرالات البريطانيين ضد الدولة العثمانية، في الوقت الذي كان عملاء بريطانيا على اتصال دائم مع آل سعود، بعد أن انتصروا على آل الرشيد خلال الحروب التي وقعت في العامين 1906 – 1907، لتكون آخر جولة من هذه المواجهات في العام 1921، بعد أن نجح الإنكليز في نقل آل هاشم من أرض الحجاز باتجاه الشمال.
ومع انتهاء الحرب العالمية الأولى وهزيمة الدولة العثمانية وتقاسم الدول الاستعمارية للأرض العربية في اتفاقية “سايكس بيكو”، ومن بعدها في وعد “بلفور”، أصبحت سوريا ولبنان من حصة فرنسا، وأصبح ما تبقى من حصة بريطانيا، فرسمت لندن خارطة جديدة لممتلكاتها في المنطقة، وأنشأت ما يسمى بدولة شرق الأردن التي سلّمتها لعبد الله بن الحسين، وعينت شقيقه فيصل ملكاً على العراق، بعد أن احتلت فرنسا سوريا.
لم تهمل بريطانيا آل سعود، فقدمت لهم ما يكفي من الدعم، حتى هزمت جماعة “الإخوان” الموالية لآل سعود ما تبقى من قوات آل هاشم بقيادة الأمير عبد الله بن الحسين في آخر معركة وقعت بين الطرفين في 25 أيار/مايو 1919 في موقع وادي تربة.
وكان ذلك كافياً لوضع ما يسمى “أرض الحجاز” برمتها تحت حكم آل سعود، بعد أن انتصروا في معركة النيصية بشكل نهائي على آل الرشيد في تشرين الثاني/نوفمبر 1921، فأعلنوا مملكة الحجاز في كانون الثاني/يناير 1926، وسميت في العام 1932 بـ”المملكة العربية السعودية”.
وبعد أشهر من إعلان آل سعود مملكة الحجاز، وقعت الكارثة الكبرى يوم عيد الأضحى، عندما وصل المحمل المصري الذي يحمل كسوة الكعبة المشرّفة من القاهرة إلى مكة المكرمة، إذ شنّ أتباع عبد العزيز بن سعود المتعصبين هجوماً دامياً على الحجاج المصريين، بحجة أن ما جاءوا به ليس إلا بدعة وشركاً، فقتلوا المئات منهم. كانت هذه الجريمة بداية العداء الديني والمذهبي والقومي لآل سعود لجميع دول المنطقة وشعوبها، وخصوصاً المد القومي الذي مثله الرئيس الراحل عبد الناصر.
وأصبح آل هاشم الذين أهدتهم بريطانيا في العام 1946 ما يسمى بالمملكة الأردنية الهاشمية في الخندق نفسه، خدمة للسيد المشترك بريطانيا، التي حلت محلّها أميركا بعد اللقاء الأول بين عبد العزيز آل سعود والرئيس الأميركي روزفلت في 14 شباط/فبراير 1946.
وقد أعلن آل سعود ولاءهم المطلق للسيد الجديد الذي حل محل السيد القديم، بعد أن نجح في الاستفادة القصوى من آل سعود وآل هاشم، وسخّرهما معاً خدمة للمشروع الأكبر، وهو إعطاء فلسطين وطناً قوياً لليهود، وهو ما وافقوا عليه مقابل وعود من بريطانيا التي لم تحتج إلى مزيد من الذكاء والحنكة السياسية لإقناعهما معاً، فقد أقامت لهم دويلات كانت، وما زالت، منذ تأسيسها خدمة للسيد الأول بريطانيا، والآن السيد الأكبر أميركا، التي أكملت مسار الإنكليز، فأعطت (بقرار التقسيم) نصف فلسطين لليهود، فأعلنوا الدولة العبرية فيها في العام 1948، فكان آل سعود وآل هاشم تارة معاً، وتارة أخرى على انفراد، ومعها الـ”آل” الأخرى، في خدمة هذا الكيان، تارة بعلم، وتارة من دون علم، وفي جميع الحالات بالخيانة والتآمر، كما هو الحال عليه الآن ومنذ أكثر من مئة عام.
ويبقى الخلاف بين آل سعود وآل هاشم بشكله الأخير، ومعه الخلافات الأخرى بين آل سعود وآل ثاني والآخرين، مسرحية لا تقنع حتى الذين يمثلون فيها، لأنهم جميعاً في وضع لا يحسدون عليه أبداً، وهم في نهاية المطاف لا حول لهم ولا حيلة، فالمسرحية مستمرة، وليس مهماً من كتب أو سيكتب فصولها من العثمانيين والبريطانيين والأميركيين واليهود، كما هو الحال في “صفقة القرن” منذ القرن الماضي!

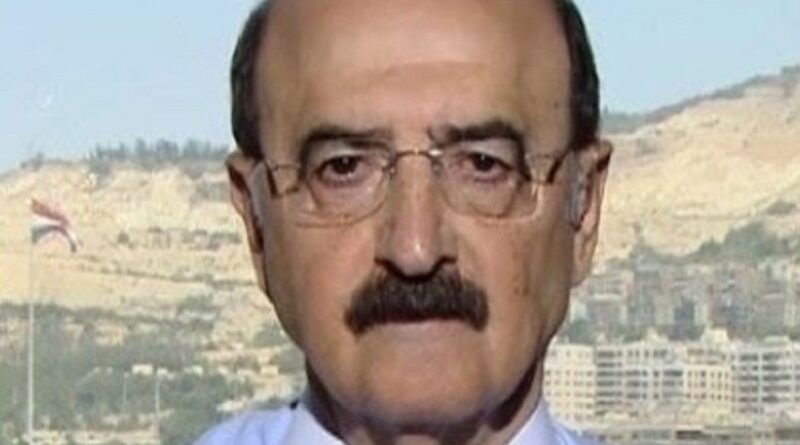
 حسني محلي
حسني محلي 

