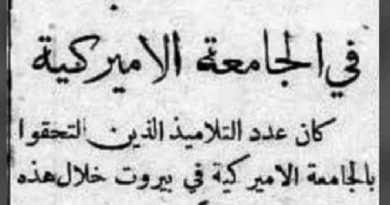حوار مجلة الهدف مع د. سيف دعنا: كلما كبُر “العرب” صغرت “إسرائيل” …
نُشر هذا الحوار الخاص مع عميد كلية العلوم الاجتماعية وأستاذ علم الاجتماع والدراسات الدولية في جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة د. سيف دعنا في العدد (29) من مجلة الهدف الرقميّة، إليكم الحوار:
* لطالما تمّ تناولُ مسألة الطائفيّة وصناعة الأقليّات، والعوامل الداخليّة والخارجيّة التي تقف خلفها، لكن هل ترى أنّ مواجهة ذلك يتوقّف على إحياء المشروع القوميّ التحرري الغائب؟ أم ما هو مطلوب أكثر من ذلك؟
** هذا صحيح، إذا فكرنا بالمشروع القومي، كاستراتيجيّةٍ (أي ليس فقط كأيديولوجيا أو عقيدة)، على اعتبار أنه كلما كبر التكتل الذي ننتمي له في عالمٍ تحكمه الإمبراطورياتُ والقوى الكبرى؛ نصبح أكثر قدرة على النجاح، أو تحقيق الأهداف والانتصار، أو الصمود بالحد الأدنى. لهذا دائمًا نقول “كلّما كَبُر العربُ؛ صغرت إسرائيل”، وأُضيف “كلما كبُر العربُ؛ تصغر حتى أميركا” و “كلما كبر العرب؛ يصبح النصر أكثر إمكانيّة وواقعيّة”. وهذا صحيحٌ، أيضًا؛ لأنّ جذور الفكرة القوميّة والمشاريع الوحدويّة/العروبيّة ارتبطت بوعي التجزئة وإدراكها، كأحد آليات مشروع الهيمنة الغربيّة. بمعنى: أن التجزئة هي إنتاجٌ استعماريٌّ غربيّ. لكن الاستعمار الغربي لم يرسم خطوط سايكس- بيكو، مثلًا، وحسب، ولم يكتب تاريخ بلادنا بأدواتٍ معرفيّةٍ استعماريةٍ عبرَ غزوٍ أيديولوجيٍّ كاسحٍ قسّمنا قسرًا لطوائفَ ومذاهبَ وأقطار؛ بل أسّس، أيضًا، لمساراتٍ اقتصاديّةٍ ومصالحَ حول هذه الخطوط وهذا التاريخ؛ لجعلها حقائقَ وأمرَ واقعٍ في خدمة مشاريع الهيمنة.
لهذا، فالمشروع القومي أو الوحدوي ليس فكرةً أو قيمةً مطلقةً؛ ولا يجب فهمه هكذا – وهو غيرُ ممكنٍ بحد ذاته؛ بسبب عوامل الاستراتيجية، وحقائق التاريخ والجغرافيا السياسيّة (حقائق المكان والزمان) – فكما أن التجزئة، بكل أشكالها (قُطرية، طائفية، مذهبية، إثنية، الخ) لها جذورٌ في الإنتاج وعلاقات الإنتاج، أو أن التجزئة لها مضمونٌ وجوهرٌ اجتماعيّ (طبقي)، فإن الوحدة، أو المشروع القومي، بالضرورة، يجب أن يتميز، أيضًا، بمضمونٍ اجتماعيٍّ اقتصاديٍّ مضادٍّ لمشروع الهيمنة. بهذا المعنى، يجب أن يستند المشروع القومي على أسسٍ اجتماعيّةٍ اقتصاديّة، تمكّنه من تأسيس حاضنةٍ شعبيّةٍ عابرةٍ لكل أشكال التجزئة القائمة، التي لها مصلحةٌ حقيقيّةٌ، ومادّيّةٌ موضوعيّةٌ في المشروع، على طريق فصلها عن أسباب تسييسها المتجذّرة في المضمون الاجتماعي للأنظمة القائمة. هكذا يقف المشروع القومي على قدميه، ودونها يظلّ واقفًا على رأسه. فالطوائف والمذاهب والأقليات يصبح لها معنًى وتبعاتٌ سياسيّةٌ فقط (خارج معناها المفترض كتعبيرٍ عن خصوصيّاتٍ ما، أو كطرقٍ في التعبّد والتقرّب الى الله) حين تصبح جزءًا من مسارٍ اقتصاديٍّ ومصالحَ يمتدّ نسيجيًّا للخارج. هكذا يتم وضع الأقليّة (الطائفة مثلًا)؛ بفعل السياسة والمصالح في مقابل الطبقة والأمة، وتشتيت القوى المتضررة من الهيمنة الاستعمارية، وصاحبة المصلحة الموضوعيّة في المشروع الوحدوي؛ هذا هو في الحقيقة جوهر التجزئة وكونها آلية استعمارية، ومنها يأتي الخلط الكارثي بين الصيغ الأقلوية (طوائف ومذاهب) والدين أحيانا. إذن، فالمطلوب أكثرُ من ذلك، أو بشكلٍ أدقّ؛ المطلوبُ هو مشروعٌ قوميٌّ بمضمونٍ اجتماعيٍّ مضادّ.
* كثيرًا ما يتم تناول مسألة الطائفيّة والأقليّات في الواقع العربي، مقترنةً بالمسألة الديمقراطيّة، في حين أنّ مسألة التحرّر الوطني ما تزال لا تحظى بالأولويّة المطلوبة، وهذه الإشكاليّة تطرح المسألتين التحرّريّة والديمقراطية قوميًّا، وعلاقتهما بالقضيّة الفلسطينيّة، فكيف تقرأ المسألة؟
** الأهم من الإجابة المباشرة، هنا، هو التشخيص (وسأتجرأ بالقول: تشخيصٌ علمي) لحال الوطن العربي: أولًا، كيف تم إنتاج الهويات الطائفية نقيضًا للطبقة ثُمّ للأمّة، وكيف أصبحت هذه الهويات – بسببٍ من طبيعةِ إعادة تشكيلها الحديث في السياق الرأسمالي، كما “الديمقراطية الليبرالية”– أهمَّ أدوات الحرب على أمّتنا، وأهمَّ أدوات خراب بلادنا. بإيجازٍ شديد، ماذا حصل للوطن العربي حتى وصلنا إلى هنا:
أولا: خلال العقود الأربعة الماضية فقط، منذ اختراق النيوليبرالية لبلادنا، خضع الوطن العربي (أو أُخضع بالقوة غالبًا) لما يسميه المفكّر الاقتصادي علي القادري عمليةَ “تنميةٍ معكوسة” (Dedevelopment) عبرَ تجريده بالقوة من قدراته وإمكاناته على النمو. إذن، لسنا أمامَ فشلٍ للعمليّات التنمويّة، أو حتى أمام تجارِبَ تقليديّةٍ لإنتاج التخلّف والتبعيّة عبرَ تبني نماذجَ تقود لكولونياليّةٍ اقتصاديّة، بل ما حصل هو تنميةٌ معكوسة. والتنمية المعكوسة؛ هي، باختصارٍ، عمليةُ اجتثاثٍ منهجيٍّ لقدرات الوطن العربي وإمكاناته؛ لعدم النمو والتطور الاقتصادي. وقد تمّت في غالب الأحوال؛ نتيجةً للحروب والخضوع لشروط الهزيمة. كل المؤشرات الاقتصادية (الفقر طويل الأمد، ارتفاع معدلات البطالة ومستويات اللامساواة، تدفق الموارد الحقيقية والمالية، الاستعمار العسكري، وغيرها الكثير مقارنةً بالمعايير العالمية)؛ تؤكد أن ما حصل خلال العقود الأربعة الماضية هو عملية تفكيكٍ متعمّدٍ ومنهجيٍّ لقدرة الوطن العربي على التحوّل هيكليًّا، ومن ثَمَّ اجتثاث قدرته على النمو.
ثانيا: في المقلب الآخر، تعرّض الوطن العربي أيضًا منذ ١٩٦٧، لغزوٍ أيديولوجيٍّ كاسحٍ قاد لما يشبه إعادة تثقيفٍ لقطاعاتٍ واسعةٍ من الناس؛ نتيجةً للهزيمة عام (١٩٦٧) وبترافق مع اختراق النموذج الاقتصادي النيوليبرالي. المهم ذكره هنا، هو أن الغزو الأيديولوجي ليس فقط غيرُ منفصلٍ عن مساراتٍ أخرى، لكن كان في أغلب الأحوال مقدمةً للعنف والحروب. وفي حالاتٍ كثيرةٍ، كانت تبعاتُ الغزو الأيديولوجي أخطرَ حتى من الحروب العسكريّة.
هكذا حصل الانقسام الهوياتي، وهكذا تم تسييس الهويات الثقافية؛ نتيجةً لتكامل هذه المسارات القاتلة (اقتصاد نيوليبرالي، الشروط السياسية للهزائم العسكرية مثل علاقات “سلام” مع العدو، الخ). هناك خطأ شائع مفاده أن الهويات الطائفية تنتمي لمرحلة ما قبل الحداثة والرأسمالية (مرحلة الإقطاع). ورغم أنه حدثت فعلًا عملياتُ إنتاج هذه الهويات الطائفية والمذهبية وتمثيلها في تلك المرحلة، إلا أن جوهر الهوية الطائفية الحديثة والتقسيمية ومضمونها، كان على حساب العمل/العمال بالمعنى السياسي، أي بوصفها فاعلًا سياسيًّا، ليس بسبب أصولها ما قبل الرأسمالية، بل كنتاجٍ للعلاقات الكولونيالية الرأسمالية، كما يشير مهدي عامل. لكن الخطأ يكمن في إسقاط ما حدث في العقود الأربعة الماضية على التاريخ؛ لتتفق هذه الرؤية مع السرديات الاستشراقية العنصرية عن بلادنا.
الهوية، طبعًا، هي دائمًا حالة سائلة ومتغيرة، بمعنى أنه ليس لها أي خاصية جوهرية أصيلة أو عابرة للتاريخ والمجتمع. ولكن خطرها في أغلب الأحوال يتمثّل بالحد من قدرة الطبقة العاملة على زيادة حصتها من الناتج الاجتماعي. لهذا، فالخطر، حقًّا، هو حين تصبح هذه الهويات وقيمها الثقافية نقطةَ تجمعٍ سياسي (كأشكالٍ طائفيةٍ جديدة، أو هويات طائفية) فتصبح ذخيرةً اقتصاديةً وأيديولوجية وحتى عسكرية فعالة لرأس المال، وضد المجتمع عمومًا، والطبقة العاملة خصوصًا. هكذا تصبح الطائفة نقيضَ الطبقة. من جانبٍ آخر، كان هناك ميلٌ واضحٌ في حالة الوطن العربي (ليس هنا مجال للحديث عن أدلّةٍ حسيّةٍ وبياناتٍ لكنّها متوفرة)، لترافق صعود هذه الهويات، وتداخلها مع التراجع السياسي والأيديولوجيا القومية، وتسارع مع هذا الصعود أيضًا الانهيارُ السياسي للطبقة العاملة والفقراء، وتراجع حصتهم من الناتج، كما يوثق الرفيق علي القادري. هكذا نفهم ما حصل كنتاجٍ للتاريخ، لا رغمٍ عنه، ونعرف، أيضًا، أننا في مرحلة تحرّرٍ وطني.
الأداة الأخرى التي استُخدمت في العدوان على وطننا العربي، وللتعمية على الصراع الأساسي كانت “الديمقراطية الليبرالية” – أنا أكتب عن الموضوع، الآن، وسينشر قريبًا؛ لأنه لا مجال للحديث مطولًا هنا – باختصارٍ، الديمقراطية هي آلية حكم، و”الديمقراطية الليبرالية” كنوعٍ محددٍ من الديمقراطية، هي آليةُ حكمٍ رأسماليٍّ يتمّ من خلالها تبادلُ السلطةِ وتداولُها بين النخبة/الطبقة الحاكمة، وليس عبر الطبقات. أي أن رأس المال العالمي يحكم عبر هذه الآلية أساسًا. لكن التعمية على هذا النوع بالذات، وإطلاق مصطلح الديمقراطية عليه، وكأن هناك صيغةً واحدةً هو جزءٌ من الصراع الأيديولوجي، وهو، أيضًا، صراعٌ طبقي/اجتماعي، أي يحدث، أيضًا، في مجال المفاهيم (صراع طبقي على المفاهيم). هذا لا يعني فقط مركزية الصراع الأيديولوجي في الصراع المحلي وامتداداته الإقليمية والدولية فقط، ولكن، أيضًا، يؤشّر لميول قوى اليمين الرأسمالي والمؤسسات والأحزاب اليمينية لاختراع مفاهيمَ جديدة، وحتى استخدام مفاهيمَ يساريةِ الأصل بعد إعادة تغيير دلالاتها كتكتيكٍ في الصراع. هكذا تعطى المفاهيمُ الأصليةُ معانيَ جديدةً مختلفةً تمامًا؛ بسبب الاستخدام الجديد. مصطلح “الإصلاح” السائد، مثلًا، الذي يُفترض أن له دلالةً إيجابيّةً لدى المستمع “العادي”، يعني حرفيًّا تبني وصفاتٍ نيوليبرالية كارثيّةٍ مأخوذةٍ مباشرةً من دليل عمل المؤسسات المالية الدولية أو أدوات الهيمنة الامبريالية المالية).
الديمقراطية الليبرالية تصبح أداةً فتّاكةً وأداةَ خرابٍ ليس فقط بتزويرها للاستبداد الحقيقي (استبداد الطبقة ذات الامتدادات الخارجية، وهم دائما يتجاهلون دور الخارج)، ولكن أيضًا بسبب القوة المادية والأيديولوجية الهائلة للمنظومة الرأسمالية العالمية التي استولدت هيمنةً أيديولوجيّةً شبه مطلقة، خصوصًا مع غياب البديل العضوي بعد سقوط المنظومة الاشتراكية. لهذا، فكل الحلول تصبح من نوع المسبب للمشكلة، مثلا؛ العمل على حل الأزمات الاقتصادية الناتجة من السياسات النيوليبرالية يكون عبرَ اتباع وصفات البنك الدولي راعي تطبيق هذه السياسات. في ظلّ وجود هيمنةٍ أيديولوجيّةٍ دوليّة، تستند إلى قوّةٍ كونيّة، وتعبِّر عنها وعن فكرها، فإنّ البديل المفترض الذي يسعى إليه الكثيرون لا يمكن أن يُنتَجَ محلّيًّا، أو “بعقلٍ محلّيّ” خالص، كما يظنّ بعضُ المتحمِّسين الذين لا يعرفون أنّ قوّتَهم وقوّةَ مجتمعاتهم، في سياق النظام العالميّ، تقارب الصفرَ في أحسن الأحوال، ما داموا يعيشون في مجتمعاتٍ صغيرةٍ، وضعيفةٍ، ومندمجةٍ في بنية النظام الرأسماليّ العالميّ، وتخضع كلّيًّا لشروط القوى المهيمنة؛ لهذا قلت: إن الوحدة هي استراتيجيّة أيضًا.
في الحقيقة، واستنادًا إلى التجربة في حالتنا العربيّة (من تونس إلى مصر وما بعدهما)، فإنّ “البديل” اُنْتِجَ، ويُنْتَج، وَفقَ نموذج الإيديولوجيا الدوليّة السائدة والمهيمنة فقط، أو وَفقًا للفكرة المسيطرة على المنظومة الدوليّة في هذه اللحظة التاريخيّة؛ بسبب بنية عمل النظام العالميّ الراهن وآليّاته. أي أن الديمقراطية الليبرالية تحقّق أهدافها نيابةً عن رأس المال العالمي؛ لأن الخيارات معطى مسبقًا لحدٍّ كبير، لأن الإمبريالية الغربية تستخدم نموذجين من التطويع، أو ما يسمى “علم أصول التربية الإمبريالي، التطويع بالعنف والتطويع بالثقافة، وكل تاريخ الإمبراطوريات الحديثة يدور إلى حدٍّ كبير حولَ دمج هاتين التقنيتين.
* الطائفيّةُ وتأجيج المذهبيّة وانشطار الدولة العربيّة، أحد أهم ركائز المشروع الاستعماري الغربي الصهيوني، ولطالما تطرح هذه الحقيقة، واقع البُنى الاجتماعية – الاقتصادية وتعبيراتها السياسية في ظل الإلحاق والتبعية والهيمنة؛ فهل من قراءةٍ جديدةٍ في مواجهة ذلك؟
** سأبدأ بمسلمات/افتراضات نظرية: أولًا، النظام العالمي هو وحدة تحليليّة واحدة، بمعنى: أنه لا يمكن فهم ما يحدث في مجتمعٍ ما بمعزلٍ عن المنظومة كلها (لا يوجد مجتمعات جزر أو مستقلة بشكل مطلق). ثانيًا: لا يزال التناقض الرئيسي في العالم هو تناقض الشمال والجنوب (أو مركز وأطراف النظام كمفاهيمَ اقتصاديةٍ سياسية)، وجوهره، طبعًا، طبقيٌّ أساسًا؛ لأنّ المنظومة قائمةٌ على النهب والاستغلال. بمعنى: أن جوهر التناقضات والصراعات في أي مجتمعٍ هي طبقيةٌ أساسًا، لكن بسبب بنية المنظومة الدولية كوحدةٍ واحدة، لا يمكن رؤية هذه التناقضات المحلية جيدا وفهمها بمعزلٍ عن كونها امتدادًا وجزءًا من تناقضٍ اجتماعي إقليمي وعالمي. ثالثًا: في هذا التناقض، هناك شمال في الجنوب، وجنوب في الشمال. فكما أنه هناك معازل وغيتوات جنوبية، بالمعنى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في الشمال (الأقليات والفقراء مثلا)، هناك وكلاء للشمال في الجنوب، وشريحة تعيش حياة شمال الشمال في الجنوب.
أحد الاستراتيجيات المهمّة طرحها الراحل سمير أمين مقترحًا لاستراتيجيةٍ تنموية، يشرحها إلى حدٍّ ما عنوانُ كتابه “فكّ الارتباط: نحو عالمٍ متعدد المراكز”. و”فكّ الارتباط” يستند، أساسًا، إلى مسلّمةٍ مفادُها أنه لا يمكن لدول الجنوب أن تحقق أي نوعٍ من التنمية (أو حتى تحسين مستوى المعيشة) إذا استمرت باتباع (والخضوع) لمعايير النظام الرأسمالي العالمي ومقاييسه ووصفاته. ومن أجل النجاح؛ العكس، تمامًا، هو المفترض والمطلوب: أي إخضاع العلاقات مع الخارج لحاجات الداخل ومتطلباته، وهذا يفترض قوةً في مواجهة الخارج – نظرية التبعية مبنية أساسًا على فكرة تشكيل البنية الاقتصادية المحلية (عبر الاستعمار، أولاً، وعبر الهيمنة الإمبريالية لاحقًا) لتلبي حاجات الخارج الاستعماري أساسًا – لهذا يرى أمين “فك الارتباط”، شرطًا ضروريًّا وأساسيًّا لأي نموذجٍ تنمويٍّ يمكن له النجاح في الجنوب، أن يتضمّن فيما يتضمّن تبني استراتيجياتٍ ونماذجَ وقيمٍ مختلفةٍ عن الشمال. لكن إمكانات وقدرات دول الجنوب، ثُمّ، قدرتها “التفاوضية” في مواجهة المنظومة الرأسمالية، وإمكانية نجاح “فك الارتباط” النسبي؛ تتفاوت اعتمادًا على عاملين: القوة الذاتية، وحالة النظام العالمي. كلما كنت أقوى يمكنك أن تكون أكثرَ استقلالًا نسبيًّا، وكلما كانت قوى المركز الإمبريالي أضعف أو تواجه تحديات تفقد إمكانية السيطرة. في الحالة العربية الراهنة، مقاومةٌ أكثر؛ فكُّ ارتباطٍ أكثر. وفكُّ ارتباطٍ أكثر؛ صراعاتٌ بينيةٌ أقل. لكن، وكما يرى أمين، يفترض أن يخضع جهاز الدولة في الجنوب لتحالف شعبي واسع، لا يعطي الأولوية فقط لحاجات الداخل على حساب الخارج، بل اعتبار “فك الارتباط” مرحلةً انتقاليةً نحو الاشتراكية، أو بشكلٍ أدقّ، اعتبار الاشتراكية آليةً لفك الارتباط. مرةً أخرى، القضية هي في المضمون الاجتماعي لأي مشروعٍ وطني، وهذا يحتاج لقوةٍ في مواجهة المركز الإمبريالي.
هناك استراتيجية أخرى تخص الوطن العربي ومحيطه تحديدًا، وهي الاندماج الإقليمي، كتب عنها العديد من المثقفين العرب، مثل: علي القادري. وفكرة الاندماج الإقليمي تعني باختصار العمل على ترسيخ التنمية في إطار السياسات الإقليمية (أي تشمل غير العرب أيضًا) يتم دعمها بتدابيرَ مشتركةٍ من القوى الإقليمية ذات المصلحة في مواجهة الإمبريالية الغربية، وتكفل المصلحة المشتركة في الإقليم. والفكرة مؤسسة على ذات الأسس النظرية التي اعتمدها سمير أمين في فك الارتباط. أي أنه بسبب كون النظام العالمي وحدة تحليلية واحدة، ولأن الإمبريالية تستخدم أساليب التدمير والحرب، لا يمكن للتنمية السليمة أن تتجذر في بلد واحد، خصوصًا، إذا كان في/ قرب منطقةٍ غير مستقرةٍ، مثل: المنطقة العربية. هذه استراتيجية شبيهة بفكرة الوحدة العربية. لكن حتى يصبح الاندماج الإقليمي ممكنا، يجب أن يكون نطاق التنسيق الاقتصادي المنظم هادفًا ضمن السياسة القائمة على الحقوق، التي تربط الوطني بالإقليمي، وتهدف أساسًا إلى انتشال أكبر عددٍ ممكنٍ من السكان من مستوى الفقر المدقع، ثُمّ تحويلهم لحاضنة لهذا المشروع في الوقت ذاته، وهذه الاستراتيجية يمكن أن تكون فعالة بمقدار، أولًا: مساهمة الأيدي العاملة ومشاركتها (لا رأس المال) في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة. ثانيًّا: مركزية الأمن المالي والاقتصادي الذي يشكل جوهر السيادة الحقيقي. لكن في كل الأحوال، قدرة أي مجتمع على فك الارتباط، كما هو عند سمير أمين، أو إمكانية نجاح أي محاولةٍ من الاندماج الإقليمي يعتمد على مدى القوة المادية والأيديولوجية في مواجهة الخارج.
* قد قلت: “كان لا بد لمشروع الوحدة أن يتميز بمضمونٍ طبقي مضاد؛ لهذا فمأثرة عبد الناصر الكبرى كانت في تبني نموذجٍ اشتراكيٍّ عالمي ثالثي، أسس لإطلاق آلية لتطور اقتصادي تلقائي تجاه الوحدة، كانت العروبة تفتقدها حتى تلك اللحظة: هل ذلك في سياق تأكيد دور “الزعيم – الملهم – القائد الكاريزمي” في الواقع العربي، أم يتوقف الأمر على طبيعة البنى وانعكاساتها ودلالاتها وتأثيراتها في تفاعلها الجدلي؟
** لا ليست القضية كذلك، بمعزل عن الكاريزما الهائلة التي تحلى بها الرئيس عبد الناصر. المسألة هي في النقاش الذي دار حول الوحدة، كفكرةٍ مطلقة أو كعمليةٍ تاريخية، وأيضًا، حول مضمونها الاجتماعي الذي تمت تغطيته في الأسئلة السابقة.
* سبق لك أن طرحت للنقاش فكرة أن النكبة “قدر” أو “احتمال بين احتمالات” هذا يدفعنا للانتقال إلى طرح آخر أي القراءة التصاعدية للتاريخ، أن نبدأ من الآن ونقرأ ما حدث وأن نتخلى عن المنهج الإنجيلي في كتابة التاريخ وفهمه. إذن، ورغم أن هذا المنهج قد لا يكون مفهومًا تمامًا، هل نبني تحليلنا لأوسلو باعتباره نتيجة للنكبة وباعتبارها قدرًا، أم باعتباره قدرًا ترتب على أي احتمال ممكن؟ لذا، فماذا تفيدنا هذه القراءة حقًّا في كفاحنا؟ وما أهمية “التفلسف” ومعذرة للكلمة، حول إن كان يتم تناول النكبة كموضوعٍ أدبي أو كسياقٍ سياسي، ما دامت مستمرةً وتحدث الآن؟
** لا أفهم ماذا تقصد بأن “هذا المنهج قد لا يكون مفهومًا تمامًا”! المسألة في الحقيقة هي منهجية سائدة في كتابة التاريخ وقراءته، تعتمد على فرضية بسيطة: يجب أن يتم صياغة السردية التاريخية وفق النتائج (من النهاية) وليس وفق الرغبات، كما هو سائد في بعض السرديات الثورية الرومانسية (طبعًا الرومانسية الثورية مهمة وضرورية في البداية على الأقل، ولكن هذه مسألة أخرى ولا علاقة لها بالتأريخ أو صياغة الاستراتيجيات). لهذا نبدأ من النهاية ونسير للبداية، بعكس المنهج الإنجيلي الذي يسرد التاريخ بشكلٍ تصاعدي. هكذا يمكننا أن نتعلّم من أخطائنا، أو على الأقل يمكننا من خلال هذا التمرين تحديد الأخطاء لفهم كيف وصلنا إلى هنا. ببساطة، السرديات الثورية لا يجب (وفي الحقيقة ليس من المفترض) أن تقود لحاضرٍ مأساوي (إذا قادت ثورتك لأوسلو فيجب عليك أن تتساءل لماذا؟ ومن أجل الإجابة يجب إعادة تركيب التاريخ وفق هذه المنهجية). ولأنه حصل كذلك، فعلينا أن نعيد قراءتنا للتاريخ لفهم الأحداث بأثرٍ رجعي (وفق نتائجها). هناك مثلٌ كتبت عنه سابقًا وهو “حركة الحفارون” التي شاركت في الحرب الأهلية الإنجليزية في القرن السابع. كانت حركةً بميولٍ اشتراكية، لكن فقط بعد صعود الاشتراكية في القرن العشرين، أصبح المؤرخون ينظرون لهذه الحركة ودورها (بأثر رجعي) بشكلٍ مختلفٍ جذريًّا عن الصورة التي سادت عنها لمئتي عام. السبب، كما يقول المؤرخ كريستوفر هيل ليس لأن التاريخ يتغير، بل لأن الحاضر يتغير، ولهذا فكل جيلٍ يطرح أسئلةً جديدةً عن الماضي، لأنه يختبره ويعيش مفاعيله بشكلٍ مختلف، ومن موقعٍ مختلفٍ عن الجيل الذي سبقه، هذا من الناحية المنهجية. من ناحية التاريخ، استعدت بعض هذه القضايا المنهجية المؤسَّسة على فلسفة التاريخ؛ من أجل فهمٍ آخرَ للنكبة، ولتفسير بعض الإشكاليّات التي وقع فيها بعضُ مؤرّخي النكبة – نحن لم نفشل سياسيًّا وكفاحيًّا فقط بوصولنا لأوسلو، بل، أيضًا، معرفيًّا لحدٍّ ما، وهو ما تجلى أساسًا في فهمنا للنكبة من جهة الاستراتيجيات الكفاحية التي استولدها هذا الفهم. في الحقيقة، النص الذي كتبته (وهو جزء من مشروع أكبر سينشر قريبًا)، كان يستهدف أساسًا نقدًا للمقاربة الحضارية للنكبة، كما جاءت في المرجع الأهم عنها في كتابي “معنى النكبة” ١٩٤٨ و”معنى النكبة مجددا” ١٩٦٧. طبعًا هذا ليس نقدًا للمفكر الكبير قسطنطين زريق بقدر كونه نقدًا للأدوات النظرية/المعرفية واللغوية المتوفرة له ولجيله حينها. لكن، وبسببٍ من طبيعة هذه المقاربة الأورو-مركزية الطابع، تم عزو بعض أسباب النكبة لعواملَ حضاريةٍ وحداثية.. الخ. لكننا نعرف اليوم أن جوهر فكرة العنف الثوري، وفي الحقيقة جوهر فكرة الثورة ذاتها، وفكرة حركات التحرّر (كيف ينتصر الضعيف، والأقل حداثة وحضارة بالمقاييس الأوروبية) يقوم أساسًا على رفض منطق المقاربة الحضارية. ثانيًا: المقاربة الحضارية مؤسسة على قَبولٍ بفلسفة تاريخ أورو-مركزية تضع الغرب الاستعماري دائمًا في موقع امتيازٍ كون تاريخه، كما يراه هو ومؤرخيه، هو معيار التطور التاريخي العالمي وفق هذه الرؤية (وبهذا المعنى هي فلسفة استعمارية أيضًا). لهذا السبب تستنتج المقاربة الحضارية، بالضرورة، أن النكبة كانت قدرًا (حتمية هزيمة الأضعف، والأقل حداثة وتعليم، الخ) وأيضًا تؤثر وتحدّد مسبقًا كيفية التعاطي معها أو تجاوزها – هناك نقد عبقري لفرانز فانون في “معذبو الأرض” لرؤية فرديريك إنجلز في قراءة لـ “رونبسون كروزر” حول حتمية انتصار المسدس على السيف، ويصفها بالصبيانية؛ لأنها لا تفسر (بل وتتناقض مع) كيف انتصر الأميركيون على الإمبراطورية البريطانية العظيمة حينها، أو انتصار الإسبان على الفرنسيين وطردهم، رغم كونهم الجيش الأعظم في العالم حينها، يضاف إلى ذلك انتصار فيتنام على أميركا، والجزائر الحبيبة على فرنسا، والمقاومة الإسلامية في لبنان على الكيان الصهيوني، وأخيرا، طالبان في أفغانستان على أميركا – هل يوجد لدى أي أحد شك في التفوق الأميركي وفق المعايير الغربية للحضارة والتقنية على طالبان؟
على عكس هذه المقاربة الحضارية التي لا تميز بين الحداثة الاستعمارية والحداثة كمشروعٍ تحرّري، أو التنوير، والتنوير الكولونيالي، فرضيتي كانت ببساطة، أولًا: رفض القبول بأن التاريخ يختزن مسارًا أو معنًى مسبقًا، كما تفترض الرؤية الحداثية الغربية (هكذا يفقد الغرب امتيازه في البنية النظرية لفلسفة التاريخ)، ثمّ ضرورة اعتبار النكبة مجرد مسار آخر واحتمال ممكن بين مساراتٍ واحتمالاتٍ متعددة أخرى كانت ممكنة تاريخيًّا، أو أنه بمقدور مكوِّنات الحاضر أو الماضي أن تؤسِّس لأكثر من حاضرٍ أو مستقبل؛ بسبب غياب مسارٍ حتميّ لتعاقب الماضي والحاضر والمستقبل. ثانيًّا، أن المشروع الصهيوني هو مشروع استعماري استيطاني بطبيعة إبادية (يصنف وفق علم الاستعمار المقارن كاستعمار استيطاني نقي/صافٍ قائم على استعمار الأرض والعمل) لا يمكن ولا يجب فهمه، ولو بالحد الأدنى، من الزاوية الحضارية (كتبت عن ذلك في مكان آخر).
في رأيي أنّ الرؤية الأولى (المقاربة الحضارية) مسؤولةٌ، إلى حدٍّ بعيد، عن إنتاج خرافة “إسرائيل” وأيضًا إنتاج الفكرة الغبية: أن “إسرائيل لا تقهر” في الوعي العربيّ، ومن ثَمّ مسؤولةٌ إلى حدٍّ ما عن الانهيار الذي أصاب صيغةَ حركة التحرّر الفلسطينيّ لاحقًا. وهذا ما يتّضح من مراجعة بعض أدبيّات الثورة الفلسطينيّة الأساسيّة، التي تكشّفتْ عن وعي تاريخيّ مشوَّه يستند إلى تسليمٍ غير نقديّ بثنائيّات استعماريّةٍ متخيّلةٍ للعالم والتاريخ (“تقدّم/تخلّف”)، فيما هذه الرؤية يمكن الاستنادُ إليها لتأسيس مسارٍ جديدٍ يصل بنا إلى نهاية الكيان الاستعماريّ الصهيونيّ وتحرير فلسطين.
القضية الأخيرة هي في التمييز بين الأدبيات السياسية والتاريخ أو التأريخ، حيث وظيفة الأولى تعبويةٌ أساسًا، فيما الثانية تاريخٌ يجب أن نعتمده في صياغة الاستراتيجيات – حتى لا أطيل، يمكن لبيانٍ لحركة فتح، مثلًا، أو لخطيبٍ باسمها، أن يردد عبارة من طراز “الطلقة الأولى”. لكن المؤرخ الجدي يعرف أن شعبنا حمل السلاح منذ عام ١٨٨٦ حين هاجم فلاحو قريتي الخضيرة والمْلَبِسْ، مقاومو فلسطين الأوائل، المستوطنة الصهيونية الأولى «بتاح تيكفا» التي أقيمت على أراضيهم المنهوبة. طلقة فتح “الأولى” لا تلغي فقط مئة عام من تاريخ مقاومة شعبنا، بل تزوّر التاريخ، لذا يجب ألا يكون البناءُ عليها أو فهمها خارج إطار الرطانة التعبويّة والحزبيّة.
* ما يزال التفكير السياسي الفلسطيني؛ يخضع لتوازنات القوة الفصائلية الداخلية، التي تستأثر في الفعل السياسي من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر تمارس السياسة وكأنها ترفع شعار “يا وحدنا”.. وهذا يطرح مجددًا مسألة الوحدة، ليس على المستوى الفلسطيني فقط، بل والقومي أيضًا: كيف يمكن فكفكة الخطاب غير الوطني وغير القومي، المرتبطة حوامله – في أغلبها – عضويًّا بالإمبريالية الغربية؟
** النقاش الذي ساد في الساحة الفلسطينية في فترة الانتخابات كشف سطحية فهم الأزمة وطبيعة المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية لدى الكثيرين للأسف، خصوصًا أنه تركز حول سؤال ساذج برأيي: مع أو ضد الانتخابات؟ ومع أنني مبدئيًّا ضد فكرة الانتخابات في ظل الاحتلال، ومع الدعم المطلق للشرعية الثورية القائمة على المقاومة في حالة حركات التحرر، فضلًا، عن علاقة البنية السياسية التي تجري عليها المنافسة كلها بمشروع أوسلو، إلا أن المعضلة لم تكن في الانتخابات بحد ذاتها برغم كل مساوئها، بل أساسًا في طبيعة الهيمنة السياسية التي كشفت عنها الاستطلاعات. فالقوتين الكبيرتين (فتح وحماس) كانتا تحظيان بما يقارب ٧٥-٨٠٪ من التأييد (تغيرت قليلًا لصالح حماس بعد معركة سيف القدس )، وكان التأييد لإجراء الانتخابات يتجاوز الـ ٩٠٪. السؤال المهم برأيي، الذي يحتاج لنقاشٍ ودراسة، ولاحقًا خطة عمل، هو سؤال الهيمنة السياسية في فلسطين. السؤال المهم هو: لماذا بعد ورغم كل ما حصل بعد ثلاثين عامًا يمكن للسلطة أن ترى (بناءً على الاستطلاعات) حتى مجرد إمكانية لتجديد شرعيتها عبر الصندوق؟ كيف ولماذا تستطيع القوى المشكّلة للسلطة (فتح أساسًا) الحصول على ثلث أصوات الشعب الفلسطيني في حالة حصول الانتخابات؟ سأضعها بطريقة أكثر قسوة لتوضيح فكرتي: كيف ولماذا تشير الاستطلاعات الى احتمال تصويت ما يقارب الثلث من المنتخبين لصالح تجديد، أو إعادة إنتاج، سلطة التنسيق الأمنيّ مع العدو ولا تتردد في تصفية المعارضين، كما حصل مع الشهيد نزار بنات، وتعتقل رموز شعبنا مثل الشيخ خضر عدنان، والبطل ماهر الأخرس، وغيرهم… وتعتدي عليهم (هذا حتى لا نقول شيئًا عن الأداء السياسي والاقتصادي، وأيضًا الصحي، كما كشفت أزمة كورونا وصفقة اللقاحات)؟
الجانب الآخر من المأزق الذي نعيشه برأيي يتمثّل بأنّ القوى السياسيّة المهيمنة، سواءً فتح أو حماس، لا تمتلك مشروع/استراتيجيّة سياسي/ة أو خارطة طريق للتحرير – أنا لا أساوي طبعًا بين القوتين، ويجب الاعتراف بالمقاومة العظيمة في غزة، ودور حماس القيادي فيها، لكن أداة التحرير العظيمة هذه تحتاج لمشروعٍ سياسي متمايز، أو استراتيجية وطنية تبني على البطولات الهائلة التي رأيناها في ومن غزة تحديدًا، وأيضًا في ومن كلّ فلسطين. لكن الباحث والمؤرخ سيلتفت الى التباين بين الأداء الميداني الفذ للمقاومة والمقاومين والوثيقة السياسية الأخيرة لحماس التي أعادت إنتاج جوهر مشروع النقاط العشرة (وحتى برطانة أقل ثورية للأسف).
لم يكن سؤال الانتخابات هو المهم، بل سؤال الهيمنة السياسية إذًا، وغياب مشروع هيمنةٍ مضادةٍ للخروج بالحالة الفلسطينية مما هي فيه. هذا يحتاج لقوى سياسيةٍ تتبنى استراتيجية حرب المواقع لتغيير موازين القوى. اللافت أن قرار السلطة إلغاء الانتخابات خشية الخسارة، والميل لتوظيف العنف أكثر، مؤخرًا، يشير لبداية خسارة الإجماع، ويعني أن الواقع الفلسطيني جاهزٌ لهيمنةٍ مضادة، لكنه يحتاج لقوى سياسيةٍ تقوده تجاه إجماعٍ مضاد. مرةً أخرى، لهذا قلت إن الطابة ليست في ملعب السلطة، بل في ملعب القوى المعارضة لها، إلا إذا كان لدى البعض أي وهمٍ حول دورٍ وطني ممكن للسلطة ومؤسساتها بعد هذه التجربة الطويلة معها.
* يعاني الوضع الفلسطيني من تأزّمٍ مستمرٍّ سواءً على صعيد المواجهة مع العدو، أو على صعيد الوضع الداخلي، خاصةً في ظل استمرار قيادة المنظمة والسلطة بالرهان على التسوية السياسية، وقَبول الاستمرار في القيام بدور الوكيل السياسي والأمني، وكذلك تغوّل يد السلطة على المجتمع الفلسطيني؛ هل لديكم مقاربةٌ غيرُ سائدةٍ في قراءة هذا الواقع؟ وما المطلوب لتجاوزه؟
** أنا أتفق مع فكرة تشكيل “جبهة وطنية” جديدة باستراتيجيةٍ وطنيةٍ بديلة؛ الخلاف والجدل حول وداخل منظمة التحرير، كجبهةٍ وطنيةٍ وإصلاحها بدأ منذ المجلس الوطني الخامس في فبراير ١٩٦٩، ولا أظن أن قضيتنا تحتمل خمسين عامًا أخرى من الحديث عن إصلاحٍ لن يأتي. آن الأوان لأن نغادر هذا المربع. خلفية تفهمي للفكرة سببُهُ قناعةٌ ناتجة من قراءةٍ منهجيةٍ وشاملةٍ لتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية مفادُها أن “الطابة” لم تكن أصلًا في ملعب السلطة والقوى السياسية والاجتماعية التي تقف خلفها. فبعد ثلاثين عامًا من المفاوضات، وخصوصًا بعد تأسيس السلطة في ١٩٩٤(أو خمسين عامًا، على أقل تقدير، لمؤرخ قرأ جيدًا مقدمات ومعالم تشكل البنية التحتية لأوسلو، وكل ما تتضمنه من منظوماتٍ سياسيةٍ وأمنيةٍ وثقافيةٍ واقتصاديةٍ مضادةٍ قبل أيلول ١٩٩٣ بكثير، ورأى التمهيد لها في انقلابٍ حقيقيٍّ وشاملٍ شهدته منظمة التحرير في حزيران ١٩٧٤ في دورة المجلس الوطني، ومشروع النقاط العشرة الذي كان بدوره نتيجةً لكارثة هزيمة حزيران ١٩٦٧) من المؤسف أن يستمر البعض بالإصرار على التعامل مع سياسات القيادة المتنفذة للمنظمة وقراراتها على أنها مجردُ اجتهادٍ خاطئٍ، أو سوءُ تقديرٍ يمكن التراجعُ عنه، ليس هكذا تفهم السياسة. فالسلطة ليست شخصًا أو حتى مجموعةً من الأشخاص، بل هي مسارٌ قاد له تقاطعُ مصالحَ محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ هائلةٍ بعد ١٩٩١، وإعادة تشكيل المنظومة الدولية، من أجل تأسيس بنيةٍ تحتيّةٍ لشرق أوسط نيوليبرالي، وكانت تصفيةُ القضية الفلسطينية الخطوةَ الأهم في هذا الطريق، وحين نتحدث عن مؤسساتٍ وأجهزةٍ وبُنًى واتّفاقاتٍ مرتبطةٍ مصلحيًّا وبنيويًّا بكيان العدو، وبقوًى إقليميةٍ ودوليّة، فيجب أن ندرك أننا نتحدث عن شبكةِ مصالحَ هائلةٍ (محلية وإقليمية ودولية) عبر ويعبر عنها مشروع السلطة، وتصاعدت بشكلٍ هائلٍ محليًّا بعد عام ١٩٩٤، لدرجة أن الكيان الصهيوني لا يتردد في إظهار قلقه على مستقبل السلطة، كما جاء في تقديرٍ لمعهد الأمن القومي الصهيوني قبل أيام. ليس هناك ما هو غريب في أن تعبر قيادة السلطة عن هذه المصالح، وأن تستمر في هذا المسار، فالتموضع الإقليمي والدولي للقوى الاجتماعية التي تمثلها السلطة كان واضحًا حتى قبل مؤتمر مدريد بالحد الأدنى (في الحقيقة أبعد بكثير)، وهو ما يفسر الترابط البنيوي لمصالح هذه الشريحة، أو هذه القوى حتى مع العدو. الغريب أن تنتظر القوى الفلسطينية الأخرى من السلطة الخروج من هذا المسار، وكأن القرار فردي، ومحض خطأ في التقدير يمكن التراجع عنه!
لهذا قلت الطابة ليست في ملعبهم، بل في ملعب القوى المناهضة لأوسلو والمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى العقائدية/الثقافية الناتجة عنه. فأوسلو ليست مجرد اتفاقية، بل شبكة مصالح تعبر عنها عقيدة وطريقة تفكير وطريقة حياة ومنظومة مفاهيمية (العدو كجار) وعقلانية سياسية بديلة (الفصل التعسفي غير البريء بين المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة) واقتصاد (اتفاقية باريس واتفاقات المعابر ليستا مجرد سوء تقدير) وثقافة وتعليم (هناك الكثير من الدراسات عن تأثير أوسلو على مناهج أطفالنا)، الخ. هذا يعني أن هناك قدرًا كبيرًا من الاستحمار للناس حين يدعي البعض أن أوسلو انتهت، أو فشلت، أو أن الكيان الصهيوني لا يطبقها، إلى غير ذلك من تبريرات الاستمرار في المسار.
المشكلة أن القوتين السياسيتين الأكبر (فتح وحماس) يحتاجان هذه المظلة (أقصد منظمة التحرير) من أجل الشرعية، سواءً للتفاوض والاستمرار في المسار الكارثي خدمةً للمصالح التي يمثلها هذا المشروع (فتح) أو لتحصيل شرعية القيادة والتمثيل عربيًّا ودوليًّا (حماس) ويتصارعان عليها. لهذا لا يمكن توقع حتى الوصول إلى صيغة توافقية (حتى لا نقل كفاحية) وإصلاح م. ت. ف والطابة الأكبر هي في ملعب حماس كقوةٍ كبرى، للبناء على الشرعية الثورية التي توفرها المقاومة (كبديل للشرعية العربية والدولية التي تحظى بها المنظمة) للدفع نحو تأسيس جبهةٍ وطنيةٍ جديدةٍ باستراتيجيةٍ كفاحيةٍ، ومشروعٍ سياسيٍّ مضاد للقائم، والأهم ببنيةٍ وهيكليةٍ تنظيميتين تمنعان تَكرار تجربة التفرد التي بدأت في المجلس الوطني الخامس (شباط ١٩٦٩) وأيضًا، تعمل على طمأنة من يخشى من الفصائل الأصغر استبدال تفرّدٍ بتفرد.
صحيح أن منظمة التحرير هي إنجاز كبير للشعب الفلسطيني ونضالاته، لكن أصبح واضحًا الآن أن الضرر والأخطار (الوجودية أحيانًا) المترتبة على استغلال القيادة المتنفذة للشرعية العربية والدولية لمنظمة التحرير وتوظيفها (كممثل شرعي ووحيد لشعبنا) في مسار أوسلو الكارثي يتجاوز بكثير حقيقة الإنجاز ومنافعه. الأهم أن الدعوة لتشكيل جبهةٍ وطنيةٍ هي أكثر من شعارٍ الآن، فبعد معركة سيف القدس أصبح ممكنًا وواقعيًّا طرحُ فكرة الجبهة الوطنية، ببرنامجٍ واستراتيجيةٍ سياسيةٍ بديلة. الطابة في ملعب القوى المعارضة للسلطة.
* في سياق الصراع الأمريكي – الصيني – الروسي على مستوى التحكّم والسيطرة على النظام الدولي، وإعادة إنتاج هذا الصراع بأشكالٍ متعددة؛ اقتصادية وسياسية وأمنية وثقافية: هل نحن على أعتاب مرحلة أفول إمبراطوريات وإحلال أخرى؟
** الجواب أكثر تعقيدًا من أن يختصر بنعم أو لا، وإن كان أقرب إلى لا. بلا شك يمر العالم بمرحلةٍ انتقالية، ولكن حتى نستشرف القادم، علينا أن نفهم أولًا النظام العالمي الذي سبق. النقاش الذي دار منذ سنوات (ولم يحسم بعد) حول تاريخ النظام العالمي يمكن اختصاره بالسؤال: هل كان النظام العالمي الذي تأسّس وهيمنت عليه أوروبا منذ القرن السادس عشر جديدًا، خصوصًا بكونه نظامًا عالميًّا، كما كان سائدًا ومقبولًا لدى المؤرّخين وعلماء الاجتماع، أم أنّ ما حدث كان مجرّد إعادة بناءٍ للنظام العالمي الموجود أصلًا، مع انتقال مركزه فقط من الشرق إلى الغرب. هذا النقاش الذي بدأته جانيت أبو لغد في كتابها “ما قبل الهيمنة الغربية ١٢٥٠-١٣٥٠” واستكمله أندريه غندر فرانك في “عودة الشرق: الاقتصاد الكوني في العصر الآسيوي” يناقش السقوط والصعود” كمفهومين، وأيضًا، كحدثين، أي إمّا حدثان منفصلان، حيث شَكَّلَ الثاني حالة قطعٍ مع الأول، وفي الوقت ذاته، مَثَّلا معًا سقوط وصعود نظامين مختلفين، أم أنهما مفهومان وحدثان مترابطان، مَثَّلا مرحلتين متمايزتين في تاريخ نظامٍ عالميٍّ واحدٍ وتاريخٍ مستمرٍّ بلا انقطاع ـــ أي هل كان النظام العالمي الذي تأسّس وهيمنت عليه أوروبا منذ القرن السادس عشر جديدًا، خصوصًا بكونه عالميًا، كما كان سائدًا ومقبولًا لدى المؤرّخين وعلماء الاجتماع، أو أنّ ما حدث كان مجرّد إعادة بناء للنظام العالمي الموجود أصلًا، مع انتقال مركزه فقط من الشرق إلى الغرب؟
رغم أنى أميل الى رأي أبو لغد وفرانك في مقابل باقي أقطاب مدرسة النظام العالمي، إلا أن ما يهم في هذا النقاش وهذا التاريخ الجديد للنظام العالمي أيضًا أنه يكشف لنا، ليس فقط، أن الاقتصاد العالمي في القرن الثالث عشر (مدهشًا في حد ذاته كما كان) لم يحتوِ على قوةٍ مهيمنة واحدة، بل يكشف أيضًا تباينًا مهمًّا (للمقارنة) مع النظام العالمي الذي نشأ منه لاحقًا، أي النظام الذي أعادت أوروبا تشكيلَهُ لتحقيقِ أهدافها، وسيطرت عليه لفترةٍ طويلة. هذا التباين (المقارنة) يشير إلى أنّ خصائص الأنظمة العالمية غيرُ ثابتة، فلا توجد طريقةٌ واحدةٌ فريدةٌ لتنظيم الأجزاء. علاوةً على ذلك، أنّ الأنظمة العالمية أيضًا ليست راكدة، بل تتطوّر وتتغيّر باستمرار. وفي هذه اللحظة من الزمن، يعيش النظام العالمي الذي نشأ في القرن السادس عشر مخاض التغيير.
قضيةٌ نظريةٌ سريعةٌ لفهم منطق تحولات النظام. النظام الرأسمالي العالمي هو أولًا: نظام، وثانيًّا: تاريخي. فكرة النظام تشرح آلية عمله (كيف تلعب شطرنج مثلًا)، وفكرة تاريخي تشرح نشوئه، تحوله، واندثاره. بخصوص كونه نظامًا، فإنه يحتوي على هياكلَ وبُنًى تظهر على شكل إيقاعات/تواترات دورية (من دورة)، وهذه الآليات تعكس وتضمن أنماط التكرار من دورةٍ لأخرى. ولكن هو تاريخيٌّ أيضًا، بمعنى: أنه لا توجد حركة إيقاعية أو تواتر يعيد النظام إلى نقطة توازنٍ ثابتة. بدلًا من ذلك يتحرك النظام على نقاطٍ متمايزةٍ من خطٍّ متواصل. حين تبلغ هذه الاتجاهات ذروتها في نهاية المطاف يصبح من المستحيل احتواء المزيد من التعويضات عن الاضطرابات المنظمة من خلال آلياتٍ تصالحية. ومن هنا يخضع النظام لما يسميه ايمانويل والرشتين “الاضطراب المتشعب” أو ببساطة التحول الكمي والنوعي.
الصراع الراهن حول الصين، والجدل حول صعودها هو صراع “حول طبيعة النظام العالمي، ومؤسساته المالية والسياسية والتجارية”، كما يقول غندر فرانك. لكن الأهم من ذلك، أنّ الصين كانت نموذجًا فريدًا جدًّا في مقاومة النموذج الغربي منذ البداية، كما يقول هيل غيتس في “محرّك الصين”. فلقد قاومت الصينُ على مدى قرونٍ الضغوطَ القادمةَ من أوروبا الغربيّة، وتمكّنت من النجاة من كلّ محاولات الإمبريالية الغربية لإعادة بناء العالم. هذا في الماضي. أمّا في الحاضر، فيبدو الآن بوضوحٍ أنّ تجربة شرق آسيا المعاصرة، وتجربة الصين، لا تتناسب جيّدًا مع أي مخطّطٍ نظريٍّ أو أيديولوجيٍّ غربيٍّ للعالم. في الحقيقة هي تتناقض مع ذلك. القضية، إذًا، أكبر من مجرّد حسابات نموٍ وارتفاعٍ في المساهمة في الإنتاج العالمي، بالمعنى الكمّي (التي تستخدم لقياس مكانةٍ وهيمنةٍ لأي قوةٍ عالمية)، بل نقلةٌ تاريخيةٌ ممكنةٌ مستقبليًّا في تاريخ النظام العالمي؛ هناك ثلاث لحظات هيمنة – تم فيها استبدال القوة المهيمنة بقوةٍ أخرى من قوى المركز – هولندا، بريطانيا، الولايات المتحدة. مقدمات التحول الجاري وطبيعة المرحلة الانتقالية التي نمر بها مختلفة، وليست مجرد استبدال للقوة المهيمنة، كما حصل في اللحظات الثلاث السابقة.
هناك بعدٌ آخرُ لتمييز الصين عن الولايات المتحدة، ويدفعني لذكره أنني أفهم أو أدرس الإمبراطوريات والإمبريالية كسوسيولوجيست، أو من زاوية علم الاجتماع أساسًا. العسكرة والحروب في حالة الإمبراطورية الأميركية تحديدًا هي مجال تراكمٍ ذاتيّ الاحتواء، والطبقة الحاكمة هي المستفيدة والرابحة الأكبر دائمًا من الحروب. بمعنى: أنه لا يوجد، وَفقَ منطق التراكم، في الحرب أي خسارةٍ ماليةٍ، بل ربح – أي أن التكاليف هي أرباح وليست خسارة، كما قد يفهمها محاسب ينظر إلى الأرقام لا عالم اجتماع يدرك سوسيولوجيا الإمبريالية. في حالة الصين وروسيا هذا غير ممكن. بالعكس، يمكن أن تفلسا من الإنفاق على الحروب بسبب هذا الفرق الهائل. ففي أميركا سندات الخزينة هي التي تموّل الحروب، والتوسّع في المعروض النقدي بالدولار هو مصدرُ التمويل والتوسّع المالي، والأهم أن هذا الدين، في النهاية، وهميٌ؛ لأنه حين يقيم بالدولار (وهو ما لا ولن تستطيع فعله روسيا أو الصين) فليس له أي قيمةٍ تناقضيّةٍ حقيقيّةٍ في الاقتصاد. وهذا الدين لتمويل العسكرة والحروب، في النهاية هو أيضًا الثروة المالية الأهم للقطاع المالي، والحربُ هي أفضلُ وسيلةٍ لضمان زيادةِ الثروة المالية. لهذا، فتوصيفُ الصين بالإمبريالية إذا لم يأتِ من ببغاوات الدعاية الغربية، فهو يأتي من جاهلٍ بمعنى: الإمبريالية، وأميركا، والصين.
https://hadfnews.ps/post/87612
حوار د. سيف دعنا “للهدف”:
كلما كبُر “العرب” صغرت “إسرائيل“
خاص بوابة الهدف