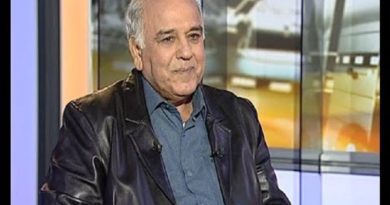روز شوملي بين جدلية جبرا وفرس الغياب!
آمال عوّاد رضوان
برعاية المجلس الملّيّ الأرثوذكسيّ الوطنيّ/ حيفا أقامَ نادي حيفا الثقافيّ أمسية ثقافيّة، تناولت الكاتبة روز شوملي ابنة بيت ساحور، في حفل توقيع كتابيْها “جبرا إبراهيم جبرا/ جدليّة الذات والمحيط” وديوانها الشعريّ “فرس الغياب”، وذلك بتاريخ 18-8-2016، في قاعة كنيسة مار يوحنا المعمدان الأرثوذكسيّة في حيفا، وسط حضور من الأصدقاء والأدباء. وقد تولت عرافة الأمسية آمال عوّاد رضوان، بعد أن رحّب المحامي حسن عبادي بالحضور، وتناولت د. لينا الشيخ حشمة ديوان “فرس الغياب” في دراسة نقديّة، ود. راوية بربارة تحدّثت عن جبرا إبراهيم جبرا في جدليّة الذات والمحيط، وكانت مداخلات من الحضور، تبعتها كلمة شكر من الكاتبة روز شوملي للحضور وللمنظمين والقائمين والمشاركين في إنجاح الأمسية، ثمّ تمّ التقاط الصور التذكاريّة!
مداخلة آمال عوّاد رضوان: سلامي لكم حَنينًا مُعتّقًا بالشوق، يُوغِلُ في حضورِكُم النّابضِ بدفئِكم! سلامي لكم مُمَوَّجًا بالألوان الرّوزيّة الورديّة، وبسِحرِ الكلمةِ الجَبْريّةِ النّافذة! سلامي لكم رنينًا متوهّجًا عذبًا، يَبعثُ نشوةً طفوليّةً، تتلاعبُ بشيْطنةٍ ملائكيّةٍ في ترنيماتِ هذا المساء، ولسنا نغفلُ عن قوْل جبرا إبراهيم جبرا: الطفولةُ هي أصلُ الكيْنونة!
إصدارت روز شوملي الشعريّة: “للنهر مجرى غير ذاته” 1998، و”للحكاية وجه آخر” 2001، و “حلاوة الروح” 2004، و “كيف أعبر إليك” 2006، و “ستعود الحمامات يومًا” 2010، و “فرس الغياب” 2014.
ودراسات تربوية منشورة في مواقع: “تاريخ رياض الأطفال في لبنان” بالشراكة مع الكاتبة سميرة خوري 1997، و”التعليم في ظل الاحتلال” باللغة الإنكليزية عام 2010.
دراسات نقدية أدبية منشورة: قراءة في إنتاج جبرا إبراهيم جبرا/ الذات والمحيط عام 2004، والبئر الأولى وجبرا ابراهيم جبرا عام 2011، والبئر الأولى وجبرا ابراهيم جبرا أديبًا عام 2013، والمرأة في روايات ليلى الأطرش، ودراسة لمجموعة نصار ابراهيم “اغتيال كلب”، ودراسة في رواية “العين المعتمة” للشاعر والروائي زكريا محمد، ودراسة في رواية “عصا الراعي” لزكريا محمد، ومراجعة لكتاب “الأرض في ذاكرة الفلسطينيين” للكاتب عبد الفتاح القلقيلي عام 2004، ودراسة عن تطور أدب الطفل الفلسطيني عام 2006، والزواج المبكر عام 2009، وكتاب المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وصنع القرار عام 2012.
لها ترجمات من الإنكليزية للعربية: رسائل من الغيتو الفلسطيني للكاتبة لينة الجيوسي 2002، و”الشعر الفلسطينيّ الأمريكيّ/ إعادة كتابة الثقافة وإعادة تعريفها: الهوية والوطن وما بينهما: للشاعرة نتالي حنضل عام 2012، و “حملة من أجل المساواة: القصة الداخلية”، نوشين أحمدي خراساني عام 2011، و”انتصارات على العنف”، مهناز أفخمي وهالة وزيري عام 2014.
لها سبع قصص أطفال: “أين اختفت فلّة” عام 1998 حازت على جائزة وطنية، و”فارس يستطيع أن يساعد” عام 1998 حازت على جائزة وطنية، و “سوا سوا” باللغتين العربية والإنكليزية عام 2002، و”في عيد الميلاد” عام 2003، و “قصص قرأوها، قصص كتبوها” بالانكليزية والألمانية عام 2003، والسمكة السوداء عام 2014، و”رغد وبيسان” عام 2014.
لها في برامج الأطفال التلفزيونية نصوص وأغاني برنامج الأطفال التلفزيوني التربوي في القدس”إحنا ونخلة” بالمشاركة مع مجدي الشوملي عام 2003، وقصيدة فيديو كليب “حلم أطفال فلسطين” عام 2003.
ولها في شعر الأطفال: قصيدة “يا للعجب”، وكتاب “حلم أطفال فلسطين”، وديوان “قوس قزح” عام 2014.
ترجمة 20 قصة في أدب الطفل العالمي من الإنكليزيّة للعربيّة لتلفزيون المركز الثقافي البريطاني، وقصة “الأميرة ذات الرداء الورقي” عام 2002.
لها مقابلات ودراسات ومقالات نقدية في النقد الأدبي والتربوي للطفل: “صورة المرأة في أدب الطفل الفلسطيني”، و”الكتابة للأطفال في ظلّ الاحتلال” عام2008، و”العنف في أدب الطفل الفلسطيني” عام2012، و”مفهوم الشجاعة في أدب الطفل الفلسطيني” عام2013.
ولأنّ الشّعرَ هو ظِلُّ الرّوح، يُباغتُ الشاعرَ على حينِ وجعٍ، فيَنمو الشاعر والشعر معًا، مُتوالِدَيْنِ فارهَيْنِ وبصمتٍ، في فضاءِ الحزن ومَعابرِ الحيْرة!
هكذا؛ انتقلتْ مِن بيتَ ساحور إلى بيتَ لحم للدراسة في ثانويّتها، إلى كلّيّة بير زيت بمنحةٍ دراسيّة، لتتخرّجَ بجائزة الطالبة المثاليّة والبكالوريوس معًا في الرياضيات، ولتفوزَ بمنحةٍ دراسيّةٍ لمدّة عاميْن في الجامعة الأميركيّة في بيروت، ولتبدأ نقطة التحوّل مع خليل حاوي، ولتتمكّنَ مِن بلورة شخصيّتِها في هزيمة 1967، بنجدةِ المُهجَّرينَ كمُسعفةٍ اجتماعيّةٍ، وإقامةً شبهَ قسريّةٍ في بيروت لرُبع قرن، لتُعايشَ مأساةَ الحرب الأهليّة والمُخيّماتِ المَنكوبة!
“رائحةُ الفِراش المُبلّلِ بالدّمِ/ ما زالتْ على جسدي منذ أيلول/ ورائحةُ الكبريتِ بلا زعتر في تلّ الزعتر/ وهديلُ الطائراتِ يَخترقُ جسدي أينما ذهبتُ/ كأنّما نلدُ/ ليُقطفَ أطفالُنا قبلَ الحصاد/ فنعيشُ الموتَ مرّات ومَرات؟ سوفَ تعودُ الحماماتُ يومًا/ كما فعلتْ في عهد نوح/ غابتْ طويلًا/ لكن أتتْ/ تحملُ غصنَ زيتونٍ وبعضَ أمل/ عادتْ/ فلا تقتلوها/ حينَ تُطِلُّ عليكم/ لا تقتلوها/ وإن عادت إليكم في الخريف.
يُدهشُنا خارجُنا؟/ تُدهشُنا وحشةُ الغابةِ ورِقّةُ الأشجار؟/ يُدهشنا داخلُنا/ يُدهشُنا جَملُ المَحاملِ ونزَقُ الصّغار؟/ فهل يُحمِّلُ اللهُ نفسًا غيرَ وُسِعِها؟
للصّيفِ رائحةُ القمحِ بعد احتراقِهِ/ ولونٌ دافىءٌ يتصبّبُ عرَقا/ للصّيفِ صرخةُ التينِ والعنبِ وقتَ البُلوغ/ واحتفاءُ النّحلِ والعصافيرِ بالغلّةِ الجديدةِ/ وللشتاء لونُ الضّبابِ يُكلّلُ جَفنَيْهِ/ بصرخةِ الغيمِ
**فرس الغياب ديوان شعري: الدائرة والمفتاح حين أغفلنا محيط الدائرة، نسينا المفتاح بداخلها هل هي الصدفة، أم الغفلة تعاندني/ كي أبحث في عُمق الدائرة/ عن سِرّ العلاقةِ بين الدائرة والمفتاح؟
مداخلة د. لينا الشيخ حشمة: رحلة تسافر فيها بين غلافي الكتاب، تراه ينقّب في أوجاعك، وقد يجعلك تتخبّط دون أن يقدّم لك حلولًا، لكنّه بالضّرورة يأخذك إلى عالمه في رحلة نفسيّة لن تكون أنت بعدها مثلما كنت قبلها. وتأخذنا الشّاعرة في رحلة إلى عالمها المعذّب بين كلمات قصائدها في “فرس الغياب”: إنّه الغياب الّذي يحتلّ كلّ شيء: هو غياب الحقيقة، غياب المكان، الوطن، المفتاح والإجابات، إنّه الغياب الملفّع بالوجع والاستلاب. مسكونةٌ هي بالقلق الفرديّ، مأهولةٌ بالحزن الوجوديّ، تجسّد الواقع في صور شعريّة مكثّفة ورمزيّة، معتمدة على الحداثة في الأسلوب والمضمون. وإذا كان واقعنا ينزف مستقبلًا مجهولًا، يغدو النّصّ مرآة له، متوافقًا مع غموضه باعتماده على الرّموز والفجوات والموتيف والتّضادّ والنّصّ المفتوح المتسائل. هكذا يتعالق الشّكل بالمضمون في فرس الغياب. وتدعو الشّاعرة قارئها إلى بناء علاقة حواريّة بينه وبين نصوصها، تجعله منتجًا وشريكًا فعّالًا، لا مستهلكًا متلقّيًا.
إنّ زمننا زمن الحداثة وما بعدها، زمن هزائم الإنسانيّة وتشويهها، زمن التّهميش والتّشييء. هو واقعٌ غامضٌ لا منطقيٌّ، مهشّمٌ لا إنسانيٌّ، مشروخٌ من القمعِ والتّيهِ. وفي ظلّ تشظّي الحياة يتملّكنا البحث عن الذّات، البحث عن النّور في الظّلمات. ويبحث النّصّ الحداثيّ في الذّات الإنسانيّة، وما يعتريها من مشاعر وصراع وأحلام، يتساءل عن كنه الإنسان ووجوده، يغوص في أعماقه، في أسرار علاقاته مع محيطه وعالمه. هكذا تغوص الشّاعرة روز في الأعماق لتنقّب في حقيقة الوجود وأحزانه. ولعلّ اختيارها للمقطوعة عن الدّائرة والمفتاح في الغلاف الأخير لم يكن عبثًا، بل تعبيرًا عن أبرز القضايا الّتي تطرحها القصائد: الغوص في الذّات للبحث عن إجابات لتساؤلات وجوديّة ومصيريّة. ففي الغلاف الأخير تبحث في عمق الدّائرة عن سرّ العلاقة بين الدّائرة والمفتاح حين أغلق محيط الدّائرة وتمّ نسيان المفتاح بداخلها. وفي القصيدة تكشف عن رمزيّة هذا المفتاح: “فالمفتاح ليس أداة غلق وفكّ/ بل دعوة للغوص/ في الأعماق/ في رمزيّة المكان/ في التّأمل في العلاقات/ بين المركز والمحيط/ بين ماضٍ وحاضر/ ومستقبل سوف يكون”(ص 30-31).
وتشدّنا الشّاعرة بَدءًا بعتبة نصّها، بالعنوان، ثمّ برسم الغلاف الأوّل، مرورًا بالقصائد النّازفة وجعًا، وصولًا إلى غلافها الأخير، إلى رحلة تتلوّى بالبحث والتّساؤل في متاهة دائريّة مسكونة بالتّشظّي. إنّها رحلة البحث في الأعماق حين يغزونا الحزن ويحتلّنا الاغتراب، فنفقد مفتاح الأمل. رحلة المفتاح حين ينغلق محيط المكان، وننسى فتحة الزّمان.. في مكان دائريّ لا يوصل، يدور بنا في فضاء لا ينتهي. وتتكرّر الدّائرة؛ ففي الغلاف الأوّل رسم للدّائرة، وفي الغلاف الأخير مقطوعة عنها، ثمّ يتكرّر لفظها في القصائد، لتمسي موتيفًا هامًّا، موتيفًا دالًّا على دائريّة الحزن الّتي لا تنتهي، على نيران القلق الّتي لا تنطفئ. وفي الغلاف رسم لدائرة ليست صافية، بل مشوّهة، فوضويّة، أقطارها تتشوّه بالخربشات والزّوائد. إنّها رمز لذواتنا في ظلّ الخراب، لدورة أوجاعنا الّتي لا تنتهي، لمتاهة هزائمنا الّتي لا تكفّ عن الصّراخ، لكن لا شيء يتغير، لأنّنا في ظلّ الغياب. ثم كيف ستبحر الشّاعرة في طريق مشوب بالتّوهان، لا تتوقّف فيه فقاعات الحزن عن الاتّساع؟ إنّ هذا الطريق لا يدركه إلا فرس الغياب. ولهذا تكشف لنا في نهاية قصيدتها الأخيرة أنّها عندما فشلت في تجاوز حزنها لم تجد إلا فرس الغياب، قائلة: “ظننت أنّني تخطّيت الحزن/ فإذا به حاضر كالجسد/ سأمتطي فرس الغياب وأبحر/ في فضاء لا ينتهي” (ص 94).
وتمتطي فرس الغياب لتبحر في هذا الفضاء الموجع، في فضاءات البوح المتناقضة، في جدليّات لا تنتهي. يتصارع تضادّها في جدليّة الحضور والغياب، في تصارع الحزن والفرح، في الوجود والعدم، في الخريف والربيع، في الصّمت والكلمات. ولا تتوقّف هذه الجدليّات عن الغليان، تثور في قصيدة ثمّ تعود لتظهر في أخرى. وهل بوسعها أن تستكين وصليبها الموجوع يربض على صدرها؟! هكذا ترسم القصائدُ صراعاتِ التّضادّ في متاهات النّفس وتساؤلاتها؛ ففي فضاءات الرّوح تتوه فضاءات البوح، تدور دورتها حول نفسها ومحيطها، وفي ذاتها، ولا تستكين. وتخطو الشّاعرة خطوتها الأولى، تقول: “غرباء على الطريق التي لا تصل/ بلا نهاية توقفنا/ بلا بداية تسجل معالم الفرح/ كلّ الأماني رحلت في الغروب/ كلّ الذكريات تنحّت للألم/ مثل المتاهات في الرّوايات الحزينة/ لا شيء يشبهنا سوى دورة الحياة” (ص11).
فنتساءل نحن: بماذا نشبه دورة الحياة؟ لعلّنا نشبهها بمتاهة مكانها الموجوع، ودورة زمانها المريرة! لا يُعنى النّصّ الحداثيّ بالإجابات بقدر ما يعنى بالسّؤال، وهو بذلك يعترف عن عجزه عن تقديم الحلول فيترك النّصّ مفتوحًا متسائِلًا، وحين يتفاقم التّشظّي وتتّسع المتاهة، ولا تجد بعد البحث إلّا هذيانًا دائريًّا، تقول: “أبحث في الوجوه/ عن الوجوه/ عن الشّبه في الوجوه/ عن أوردة الحزن/ عن شرايين الفرح/ عن الحبّ/ عن الكره/ عن رنين الصّدى/ عن اغتيال الصّبا/ عن شظايا العمر الّذي قضى/ بين تيه وانتظار/ أبحث في الوجوه/ عن الشّبه في الوجوه/ عن المهد/ عن اللّحد/ عن العلّة الأولى/ عن القصد/ عن ماهيّة الأشياء/ عن وجودي/ عن غيابي/ عن أسئلة لم يطلها جوابي/ عن جواب/ لم يدغدغه سؤالي/ عن جروح لم تندمل/ أبحث في الوجوه عن الشّبه في الوجوه/ عن تفاصيل المكان/ عن جنوح الزّمان/ عن ذكريات لم يظلّلها غيابي/ لا شيء في الوجوه… فقط… تأتأة الزّمان السّاخر… وهذيان دائريّ”(ص 58-60).
لا شكّ أنّها تكشف أشدّ حالات التّمزّق النّفسيّ الّتي تعيشها الذّات الإنسانيّة المهشّمة في عصرنا الضّبابيّ المفكّك هذا، إلى درجة بات فيها الإنسان يتساءل عن علّة وجوده وماهيّة الأشياء. وفي قصيدة “مفاهيم غير رياضيّة” تفسّر المفاهيم الهندسيّة برؤيا رمزيّة، فيها ترسم صورنا نحن. إنّها أشكالنا المرهقة. إنّها ذواتنا المشوّهة حين نغيّب في واقعٍ قد أعيا في داخلنا الإنسان، فتقول: “الدّائرة لا منبع لها/ ولا مصبّ/ تحتضن الكون ولا تكلّ / تنبع من نفسها/ وهي لنفسها مصبّ/ الدّائرة تطوّق نفسها بنفسها/ هي دولاب الزّمن الّذي لا ينتهي/ النّقطة مكان في اللّا مكان / شبه المنحرف مستطيل ضلّ الطّريق/ المربّع غرفة غادرتها النّوافذ والأبواب/ الخطّ الدّائريّ يدور حول نفسه ولا يملّ الدّوران/ الخطّ المنكسر أرهقته الصّدمات ولم يفق من آخر صدمة له بعد/ الخطّ المنحني ظهر أعياه الزّمن/ الخط ّ المتعرّج قلق العمر الّذي لا ينضب” (ص71- 73).
تكرّر الشّاعرة الأفكار والمفردات بصيغ مختلفة في قصائد كثيرة، فباتت بعضها موتيفات تحمل دلالات متعدّدة. ففي أزمة النّفس يكثر التّكرار دون وعي، وفي غياب الصّحو تتكرّر الأسئلة، ويمسي أفظع سؤال تسأله أمام المرآة: “من أنا؟ من هي تلك الّتي تراها في المرآة؟” (ص32). وفي غياب اليقين وحضور الشّكّ تتواجه الذّات مع نفسها وتبحث عن هويّتها، عن ذواتها، فيحضر الحلم ويطغى اللّاوعي، وتتساءل: “في الحلم تفاجئنا دواخلنا/ هل هي الصّورة عنّا؟/هل نحن من نرى في الحلم؟ /أم أنّه آخر يشبهنا؟/ كي نبحث في داخلنا عمّن نكون؟” (ص15). وفي خضم قلقها وتشرذم ذواتها تبحث عن الطّمأنينة في الحلم، فالحلم تجاوز للواقع وهروب منه، وهي تعي قدرة الحلم على كسر القيود، وعلى تحقيق ما لا يمكن تحقيقه في الواقع المسكون بالتوتر، ففيه تفتح أبوابًا لا تجرؤ على فتحها، وتتجاوز المكان والزّمان. وفي الحلم يتكسّر الخوف ويختفي(13-15). إنّه صراعها في خضّم مكان وزمان مشوّهين مثيرين للخوف، تبحث فيهما عن مستقرّ: لأنّ “مستقبلها قلق”، و”حاضرها يسير بلا هدف”(ص55)، و”حصانها مرهق من التّرحال بين المدن البعيدة/ والجهات الألف” (ص56).
وفي غياب الفرح وحضور الألم تحتضر الذّاكرة، وتضيع في الطّرقات ذكريات الأحبّة. وتتساءل: “هل الذّاكرة أقوى أم أنّ الحبّ أبقى من النّسيان؟ (ص54) إلّا أنّ “الكلمات تهرب من ذاكرةٍ أضاعها النّسيان”(ص57)، و”تتجوّل في مهبّ الرّيح”(ص55). إنّها الرّيح الّتي تتكرّر في القصائد لتشكّل موتيفًا آخر، تتكرّر متآمرة مع الغياب في سطوة المتاهة، ودورة الهذيان.. فللرّياح خاصيّة الدّوران. وتتساءل باحثة عن المحطّة الأخيرة، عن الخلاص: “كم عقدًا يا ترى؟ كم سنة/ كم يومًا بقي؟ كي تصل السّفينة محطّتها الأخيرة!” (ص44). أمّا الحبّ فلا يبرأ من صراع الرّبيع والخريف: “إنّ الحبّ فقد بين الفصول جذوة النّار الأولى”، “كيف صار رمادًا دون أن ندري؟ هل هي دورة الحياة واعتيادها، ذبلت جذوتها فانطفأ”؟!(ص29). أمّا في بحثها عن الحقيقة، فتتساءل: “هل نرى جوهر الأشياء أم نقيضها؟ (ص50)، مدركة أنّ “لا شيء ثابت سوى الموت” (ص48)، وهي تحذّر قارئها من جنونه، “فليس للموت عنوان، هو في كلّ مكان” (ص47).
ومهما حاولت الشّاعرة أن تبديَ تفاؤلًا إلّا أنّ الحزن يسيطر، فعتمة الواقع لا ترحمها وتكشف عن تمزّقها، إذ تباغتها القصائد وهي لا تزال تبحث عن قلم، ويعاتبها الجمال ولا ترى سوى العتمة، والعمر يغافلها ولا زالت تبحث عن وطن، فتتساءل: “كم قطارًا سوف يمرّ ولم تحدّد وجهتها بعد؟”(ص74). ثم كيف لا تعيش الشّاعرة هذا القلق وفي بلادها رائحة الموت القريب تفوح؟ّ! تقول: “في بلادي: الموت ضيف ثقيل يهلّ كعادة يوميّة/ في بلادي النّجاة مرهونة باحتمال الصّدفة/ في بلادي تشاهد القذيفة الّتي قد تحمل موتك/ ولا وقت كي تفرّ”(ص78). ويحتلّها الحزن الوجوديّ في قصيدة “متى”: “كم قلت سوف أعلن التّمرّد على الحزن/ لكنّ الحزن احتلني كأرض طيّعة/ ضعيفٌ هذا القلب/ لم يعد يحتمل كلّ هذا الوزر/ مرآة مقعّرة للحزن هذا القلب/ كأنّني، كأنّني منذورة لأحمل شجن العالم..” (ص 88- 89). لكن “لا شيء ينعشها سوى القلم”..(ص11)، وهي تقول في الحبر وخربشته ما تخشى أن تقول: “الكتابة/ همس الكلمات/ وانعتاقها/ هي حديث الذّات/ مع الذّات/ أو جذوة الانفصال”(ص21). وفي أثر الكلمات تقول: “معتقل أنت في نفسك/ مكبّل بالغضب وإرث الغياب/ الحزن شفيف/ حدّ الكلمة سيف/ والغضب حبرٌ ناقص الكلمات/ لسنا وريقات تهزمها الرّيح/ لكنّنا نهتزّ بالكلمات”(ص19).
وفي غياب الكلمة يحلّ الصّمت: “الصّمت يحمل احتمال المجاز في انقطاع الكلام/ هو الغضب،/ الخوف،/ القهر،/ الألم،/ هو النّدم،/ هو العتاب،/ العقاب،/هو الجواب في انعدام الجواب/ الصّمت لغة لم تطأها الحروف/ الصّمت صَوْتٌ لمن لا صوت له/الصّمت سَوْط/ فاحذر لسانه!”(ص22). وعليه، فإنّ الكلمة للقلب المجروح خلاصٌ، إنّ الكلمة لشاعرة مأهولة بهذا الحزن الوجوديّ ملاذٌ، فالكلمات في الشّعر عندها تتحوّل: “إلى صلاةٍ/ الكلمات هي معبر الرّوح إلى الرّوح../ كالزّهرة تنبت الكلمات/ تتفتّح/ تنثر بذورها كي تعيد للحياة دورة الحياة/الكلمات ليست حبرًا على ورق/ هي أغنيات القلق المجرّح/ في اللّيالي الحزينة”(ص16- 18). لكنّها في حرقة الذّات ولهيب الأسى ستهذي وتنكر معرفتها بالشّعر، وتتحوّل إلى الشّكّ، إلى الغياب والهذيان: “تسألني عن الشّعر../لا أعرف ما يكون/ربّما هو الصّدى/ أو اللَّظى/أو خيالنا الّذي/ يرى/ ما لا نرى” (ص26). وفي قصيدتها الأخيرة تتخبّط بين الأمل والحزن، بين الفرح والحذر، بين الاستسلام والتّحدّي، لتعلن أنّها اكتفت من الغوص في العمق، لأنّ الحزن لا يبرح القلب، وهو كالجسد حاضر. ولأنّ المتاهة لا تكفّ عن الدّوران، ستمتطي فرس الغياب وتبحر في فضاء لا ينتهي. ولعلّها بذلك تكشف أنّ الغياب خلاصٌ لمن يحمل صليبًا يسكب وجع الأحزان. ولعلّ الغياب ملاذ القلب في عتمة المكان، في ظلّ هذا التّشظّي والتّوهان. ويبقى سؤالها الأعظم، ويبقى سؤالنا، سؤال الإنسانيّة: “متى/ متى نطفئ الحزن/ في منفضة الأمس/ ونقول وداعًا أيّها الحزن؟!”(ص96).
مداخلة آمال عواد رضوان: في ظل الحاجة وصراع البقاء العنيف وعزة النفس فإنّ جبرا إبراهيم جبرا يشكّلُ مجموع آبار ظامئة للحياة وللعدالة الاجتماعية، عميقة بتجاربها القاسية، صارخة بأصواتها الحزينة، تعجّ بالمحفزات والابداع وبرؤى الفرح، فطفولة جبرا كانت غنيّة بالتذوّق الجَماليّ وبالحسّ الموسيقيّ، شكّلت أرضيّة صلبة شيّد عليها أفكار الموسيقيَّة والتشكيليّة والنقديّة الفني ليشكل مع الفنان جواد سليم جماعة بغداد للفن الحديث عام 1951. **ذاكرة جبرا هي هُويّته الحقيقيّة وجواز سفره عبر جسور إبداعاته، فهي تحمل بيت لحم بعاداتها وطقوسها، بطبّها الشعبي وعرّافيها، بفلاحيها وبدوها وسكانها، بمعلميها وحِرفيّيها مِن صدّافين وسبّاكين وحجّارين، بناسها العاديّين ومُصَلّيها وسياسييها، وبكل أحداثها الكبيرة والصغيرة. أمّا روح جبرا فقد تجسّدت بسلطة معرفته الأدبية المشحونة بالقصص والحكايات والتراتيل البيزنطية أوّلا، وبسلطة خياله المجنح بالمفاجآت والمحموم المغامرات، والطافح بإبداعه المتميز بالتشويق والمتعة ثانيا! فماذا عن ذاكرة جبرا وعلاقته بالسيرك ورقص الغجر والدلعونا وباحة الميلاد والفصح والإجازات والطبيعة والحيوانات ومراقبة أدق تفاصيلها؟ وماذا عن علاقة جبرا بالأديرة والكنائس والايقونات في بيت لحم وبيروت، والتراتيل والكورال وعزف الكلارينيت والرسم والتمثيل المسرحي والفن السابع؟ وماذا عن جبرا ومملكة الجوع والموت، وعن مرضه ورعبه من العتمة ومواجهة المارد؟
مداخلة د. راوية بربارة/ جبرا إبراهيم جبرا في “البئر الأولى”: مساؤكم ينضح بالحبّ والحبر والتواصل من بئر العطاء الذي لا ينضب، بئرِ الأدب الذي ننهل منه ولا نرتوي، بل نظمأ ونتعطّش لرشفاتٍ أخَر. أن تحتفي حيفا بجبرا إبراهيم جبرا، وببحثٍ عنه، يعني أن ننهل من البئر الأولى، تلك السيرة الذاتيّة التي كتبها جبرا، ومن عيني طفلٍ بيت لحميّ- مقدسيّ، وُلِد بعد الحرب العالميّة بقليل 1920، وعاش فترةً أرّخها في رواياته، سآتي على ذِكر قسمٍ منها في قراءتي هذه.
لماذا يحقّ لجبرا أن تحتفي به الدراسات؟ وأن تحتفي به روز الشوملي، وأن تحتفي به الليلة حيفا؟ لأنّه قبل كلّ شيءٍ فلسطينيٌّ، وفخرٌ لنا جميعًا أن يكون جبرا منّا، جبرا الرسّام، الناقد التشكيليّ، الروائيّ، الشاعر والمترجِم. جبرا صاحب البصمة الخاصّة في النقد، فهو متابعٌ لحركة الفنّ والأدب والثقافة العربيّة والعالميّة، يقرأ ويكتب النقد عن الرواية، والسينما والفنّ التشكيليّ. جبرا أفضل مَن ترجم شكسبير في رأي معظَم النقّاد. جبرا السريانيّ الأورثوذكسيّ، الذي أعلن إسلامه، وتزوّج من كرديّة عراقيّة، وأنجب منها ولدين، جبرا صاحب الاسم الآراميّ ومعناه القوّة والشدّة، وأيّامه وذكرياته، وكتاباته وأشهرها “السفينة”، و”البئر الأولى”، و”شارع الأميرات”، و”البحث عن وليد مسعود” وغيرها ممّا وصل عددُه إلى حوالي سبعين مؤلّفًا، تشهد له بالقوّة في تعامله وتعاطيه مع الواقع. جبرا يستحقّ منّا لقاءًا حتّى لو لم يكن بيننا، فمن كتبَ وأبدع مثله لا يموت، وقد اخترت أن أتركّز في روايته الرائعة “البئر الأولى” تلك الرواية التي يروي لنا فيها سيرةَ طفولتِهِ في بيت لحم والقدس، “لأنقلَكُم إلى ذكريات وأحلام هذا الطفل، عملًا بقول جبران: “الماضي ما هو إلّا ذكرى اليوم، والغد هو حلم اليوم”، وترتكز مداخلتي حول محوريْن من محاور الرواية: محور السّرد، ومحور القراءة التناصيّة التي يدعونا إليها الكاتب.
المحور الأوّل، السرد: لقد استطاع جبرا إبراهيم جبرا الكاتب الكبير أن ينفصمَ عن ذاته، وأن يستخرجَ منه ذاكَ الطفلَ القابعَ هناكَ عميقًا، يرقب ويترقّب، ويدير شريطَ حياته وذكرياتِه، لنعرف معه، كيف يمكن للأديب أن ينشأ، كيف يمكن للمبدع أن يتبلور، كيف أنّ التجربة الذاتيّة هي مادّة الكتابة الأولى، ولا بدّ أن يظهر الكاتب في مقاطع من حياته في شِعره ورواياتِه، مهما أنكرَ ذلكَ، وتكون هي المواقع الأصدق في الرواية على محاولةِ تكذيبِها، وتكون هي المواقع الأجمل والأقرب إلى القرّاء على محاولةِ تعميمها. وقد صرّح جبرا قائلاً في حوار أجراه معه ماجد السامرائي: “خذ إحدى قصص “عرق”: قصة “الغراموفون”. إنها جزء من تجربتي حين كان عمري ما بين الثالثة عشرة والرابعة عشرة. أو قصة عنوانها “المغنون في الظلال”. أعتقد لو أنني لم أكتب هذا الشيء لكان هناك نقص دائم.. جرح نازف في كياني..” يعتبر جبرا عدمَ البوحِ جرحًا غائرًا في كيانه، لا يداويه إلّا بالتصريح، والبوح والكتابةِ. وهذا ما فعله في السيرةِ، فهو لم يسردها ليؤرّخ لنا تاريخ بيت لحم والقدس وفلسطين في تلك الفترة، وقد ذكر في مقدّمة روايته: “أنا لا أكتبُ هنا تاريخًا لتلك الفترة، ثمّة من هم أجدر وأعلم وأبرع منّي في سلسَلةِ ووصفِ أحداث العشرينات وأوائل الثلاثينات في فلسطين” وهو لم يؤرّخ لعائلته، ولا لبلدةٍ كانت صغيرة لا يتعدّى سكّانها خمسة آلاف نسمة، ولا تتعدّى مدارسها الطَوْرَ الابتدائيَّ، بل وكما يقول: ” ما أكتبهُ هنا هو شخصيٌّ بحت، وطفوليٌّ بحت، ومقتربي يتركّزُ على الذات إذ يتزايد انتباهها، ويتصاعد إدراكها، ويعمق حسّها، ولا تنتهي بالضرورة حيرَتُها”. إذًا يكتب كي يفهمَ، كي يحاولَ أن يمحوَ آثارَ الحيرةِ التي ارتسمت على أيّامِه، فنحن حينَ نكتب، ننفعلُ، نتفاعلُ، نتذكّرُ، نعيشُ ونعايشُ الحدثَ، وربّما لأنّنا ابتعدنا عنه سنوات، نحاسبه، نحاكمُهُ، أو نحاكمُ أنفسَنا، أو على أقلّ اعتبارٍ نحاول أن نترجمَ هذه الحيرى التي تملؤنا إلى واقعٍ نتخطّاه، لذلك كان السرد بانفصامِ الشخصيّة، ترك جبرا عمرَه الحقيقيّ، وعاد طفلًا صغيرًا، طفلًا يروي لنا بلغةِ طفلٍ، بمشاعرِ طفلٍ، بصدقٍ طفلٍ، بتساؤلاتِ طفلٍ، أحداثًا يحاول أن يتخطّاها، فها هو يسرد لنا قصّة الهيطليّة، حين كان صغيرًا، سأقرأ لكم منها مقطعًا لأدلّل على نقدي، وأدلّل على قوّةِ كاتبٍ استطاعَ أن يستعيرَ من طفولته المرحَ، والأحلامَ والرؤى، والواقعَ والخيالَ واللّغة وأن ينصَّها لنا حكايةً تجعلنا نبتسم، نفكّر، نتحايل على الكلمات لنفهمَ ما أراد أن يفهمَه الكاتب من تلك الواقعة.
ولو قرأنا واقعةَ الدفتر الذي اشتراه بنصف قرش أخذها خفيةً عن عيني أمّه من جدّتِه، وركض ليشتريَ دفترًا يكتب فيه الحروف التي تعلّمها اليومَ في المدرسةِ، وهو يذكرها ويذكر شكلها، ولكنّ عبده جاره في مقعد المدرسة أغواه بصنع طقّيعة من الورق، بورقة واحدة من منتصف الدفتر، وهكذا أعجبته الطقّيعة، فصنع بورقةٍ ثانيةٍ كما صنع عبده، وخرجا إلى الشارع يطقّعان، فالتم حولهما الأولاد الذين تقاسموا دفتر جبرا بسرعةٍ وحوّلوه إلى “طقّيع” ملأ الشارعَ صخبًا، وملأ خدّ الصغير لطمًا حين اكتشفت والدته أنّ الدفتر ليس مع المعلّم، بل تحوّل إلى رزمة طقاقيع. نفهم من الحكايتين السابقتين أنّ ما يستحثُّ الذاكرة، هو تلك الأحداث التي ترقد هناك عميقًا في جوفِنا وتأبى أن تزول، تأبى أن تخزَّنَ قبلَ أن تمحى، وتأبى أن تمحى لأنّها فريدة، مميّزة، صقلَت جانبًا من شخصيّتنا دون وعينا، وشكّلت مدماكًا في بنيتنا النفسيّة الإبداعيّة دون أن ندرك.
أمّا المحور الثاني وهو محور القراءة التناصيّة، فهو محورٌ تميّزَ فيه جبرا، الذي رفضَ أن يكرّرَ نفسَه، والذي اعتبرَ الكتابةَ تفريغًا أحاديَّ المرّةِ، فإذا ما وردت قصّةٌ كان قد فرّغَها في روايةٍ سابقةٍ أشار في الهامش، إلى الإحالات القرائيّة، طالبًا من القارئ أن يقرأ الروايةَ السابقةَ التي ذكرتِ الحادثة. وهنا استوقفني جبرا، أيريد منّا أن نقراَهُ قراءةً متمعّنة.؟ أم يريدُ منّا أن نقراَ كلَّ نتاجِهِ؟ أم أنّ التفريغَ الأوليَّ للحدثِ هو الأصدق، هو الأجمل، هو الأقرب، ولا حاجةَ لتكرار المشاهد في الروايات؟ إنّ هذه المحاولات للإحالات التناصيّة، أي تداخل نصّ في نصّ لنفس الأديب، إنّما أتت برأيي لدرء أيِّ خللٍ يمكن أن ينتجَ من الإبداع المكرَّر. ما يؤكّدُهُ جبرا بفعلتِه تلكَ أنّ الأدبَ مرآةُ الواقعِ شئنا أم أبينا، وضعنا أقدامَنا على الأرضِ أم حلّقنا في الخيال. وأنّ الأدبَ تجربةٌ نغنيها ونغنيها ونخمّرُها نبيذًا معتّقًا لتصبحَ أصفى وأرقى، فما الأدبُ إنْ لم يكن مِكنزَ تجاربٍ خضناها وأثّرت في نفوسِنا، وصقلَت شخصيّتَنا؟ وما الأدبُ إن لم يكن إحالاتٍ إلى واقعِنا المعيش، وواقعِ من حولَنا؟ وما الأدبُ إن لم يتعاطه القارئُ بضحكةٍ، بدمعةٍ خفيّةٍ، ببسمةٍ، بمحاكاةٍ، بمحاولاتٍ للبحث عن نظائره وشبيهاته في حياتِنا؟ ما الأدبُ إنْ لم يستحثُّه النقد، ولم تفرك حجارةَ كلماتِهِ دراساتٌ تُطلقُ الشررَ لقراءات وإبداعات جديدة.
كلّ أمسية ونحن نستذكر كبارَنا، فما الأمم إلّا بمثقّفيها ومبدعيها وفنّانينها، وقرّائها الذين يرسمون مستقبلًا أفضلَ لماضٍ مهما كانت قسوته يبقى الموجَ الذي اعتليناه، والعبابَ الذي خضناه لنصلَ شاطئَ الحكايةِ، وشاطئَ الحاضرِ بأمانٍ. كلَّ ليلةٍ والطفولةُ بئرُنا الأولى التي غرفنا منها مياهنا، ونظّفناها مرارًا لنحفظها طاهرةً من الشوائبِ، نرشفُ من مائها لنحافظَ على وجهِ مائنا أمام الأمم ونتركها بئرًا لا ينضبُ حبرُها.