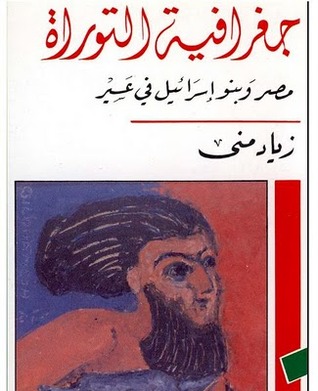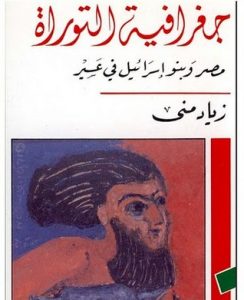«مصر وبنو إسرائيل في عسير»: زياد منى على خطى كمال الصليبي – يوسف أصفر
قراءة في كتاب: «مصر وبنو إسرائيل في عسير»
«مصر وبنو إسرائيل في عسير»: زياد منى على خطى كمال الصليبي
يوسف أصفر
في الطبعة الثانية من «مصر وبنو إسرائيل في عسير» (دار قدمس)، يقسّم زياد منى بحثه إلى فصول عشرة، يبدأها بمدخل يعرّف من خلاله القراء إلى منهجه ويتبعه بعرض للمعضلات المنهجية. وبينما يفرد مساحة متوقعة لمحاولة البحث في جغرافية مصر وفي سياستها، فاعلاً الأمر نفسه في عسير، يسعى للإضافة إلى اشتغالات كمال الصليبي عندما يبحث في فصول منفصلة حقيقة الآثار وحقيقة البحر، وعلاقتهما بالتوراة حسب درجات ورودهما في النصوص
إذا أمكننا الاكتفاء بفقه اللغة وسرد التاريخ عبر هذا المنهج وحده، فلا مجال لإنكار العمل الكبير الذي قام به المؤرخ الكبير كمال الصليبي في البحث عن تاريخ جديد للتوراة. وهو عمل لا يمكن إنكار جدّيته بأيّ شكل من الأشكال، خاصةً أن سيلاً من المؤرّخين اتّبع طريق الصليبي، وقد يكون زياد منى من أبرزهم. سريعاً، سيلاحظ قارئ «مصر وبنو إسرائيل في عسير»، أن الباحث ذهب أبعد من عسير وإن كان ملعبه الأساسي بقي يراوح بين مصر وعسير، أو جزيرة العرب، حسب المصطلح الذي يستخدمه في فهارسه ونصوصه. وهو في ذلك بوضوح تام يجعل مساحة بحثه أكثر اتّساعاً، ولكنه لم يضِف إلى أدوات الصليبي ما يمكن استخدامه من أدوات، مكتفياً عموماً بنوع من فيلولوجيا مقارنة. وهذا النقد لا يعطّل عمل الباحث أو يفقده قيمته، لكن استبعاد الأركيولوجيا على وجه الخصوص وبقاءها على طرف النقيض من النتيجة ليس في مصلحة البحث. سيلاحظ القارئ أيضاً في مواضع كثيرة معرفة الباحث الكبيرة بالمادة التي يضعها بين أيدينا. يعرف التفاصيل والأسماء ويعرف التوراة إلى درجة تخوله الحديث عنها، رغم صعوبة هذا المسلك وكثرة المنعرجات الوعرة فيه.
يهتمّ البحث جدّياً بعلاقة مصر بجزيرة العرب، وليس بعلاقة مصر بفلسطين، وهذا طبيعي بالنظر إلى عنوانه. أما المستغرب فهو إعلان منى، قبل أن يذهب لقراءة النقوش المصرية، أن هدف هذا البحث ليس طرح الأسئلة، وإنما اطلاع القارئ على مدى التناقضات التي تنخر النظريات التقليدية المتعلّقة بالتاريخ القديم لجزيرة العرب. ومن دون أيّ تردّد، يمكن التأكيد أن هناك تناقضات كثيرة تنخر النظريات التقليدية المتعلّقة بالتاريخ القديم لجزيرة العرب، خاصةً بعد الغلو في الاستشراق، وما سبقها من غلو في سيطرة اللاهوت على التاريخ. ومن دون أيّ تردّد، يمكن التأكيد أن هذه التناقضات تسوغ النظر في بعضها. التحفظ الوحيد على الطابع القطعي للإجابات الذي يطرحه الباحث، عندما يقول إن هدف العمل هو تقديم إجابات محدّدة عن أسئلة ما زالت من دون إجابة، يرى أن المنهجية الأصح هي إعادة قراءة بعض النقوش المصرية الجغرافية التي تنقل أخبار غزوات بعض ملوك مصر في آسيا. ولا يحتاج الباحث لأن يكون متخصّصاً في التوراة إلى درجة عميقة، ليجزم بأن هذا المنهج ليس كافياً وحده. رغم ذلك، في هذا الفصل يقوم بجهد كبير، يبدو استكمالاً لجهد الصليبي نفسه، ولكن لعدّة اعتبارات يصعب من الناحية المنهجية اعتباره في خانة القراءة النقدية للتوراة.
لأن المسألة معقّدة لغير المختصّين بالعهد القديم، ربما ينبغي شرح الفارق بين القراءة النقدية للتوراة على تنوع شعابها، وبين القراءة الفيلولوجية التي بدأها الصليبي وتابعها تلامذته ولا سيما زياد منى. تذهب القراءة الأولى، وهي القراءة النقدية، إلى داخل التاريخ، ولا تكتفي بحدوده الجغرافية، حيث إنها حتى عندما تعتمد في جوانب منها على الفيلولوجيا، فإن من مهامها الأساسية نزع الأثر اللاهوتي عن الكتاب المقدّس، وتفسير التناقض بين الأسفار، وتالياً إعادتها إلى التاريخ بوصفها كتباً بوضعها الحالي خارج التاريخ. أمّا منهج صليبي ومنى وفاضل الربيعي وغيرهم، فرغم أنه يطلب معرفة موسوعية بالكتاب المقدس، لفهم رموزه وشخوصه ومقارنتها بحدود جغرافية غير الحدود التي نعرفها، إلا أنه يبقى قراءة غير نقدية بالمعنى الدقيق للكلمة، لأنه لا يشكك في حقيقة النصوص وصوابية ترتيبها، بل يشكك في فهم التاريخ ضمن الدائرة الجغرافية وحسب. والفكرة الأخيرة، قد تُفهم من قِبل كثير من الباحثين بأنها قبول للتاناخ ككتاب تاريخ يمكن اعتباره مصدراً، وهذا ليس شائعاً أو مسوّغاً في دوائر نقد الكتاب المقدّس.
رغم كلّ شيء يسير زياد منى وفق منهج واضح. برأي كثيرين هذا يجعل البحث متيناً. غير أنّ كثيرين أيضاً سيسألون عن صوابية المنهج بالذات لهذا البحث بالذات، هذا إذا استثنينا النقد البنيوي الذي يستحسن إحاطة أشمل خاصةً في دراسة شائكة إلى هذه الدرجة. من الإيجابيات أن المنهج الفضفاض الذي يعمل منى على أساسه، سمح له بتخطّي عسير إلى الحدود الطبيعية لليمن كما نعرفه اليوم. وهذا ما سمح له أن يدقق في فرضياته خارج حدود المكان، واستفاد من حدود اللغة الواسعة، ولا سيما في مسألة سبأ، أثناء محاولته عرض «المعضلات المنهجية» في بحثه. لكن الاكتفاء بالمنهج الفيلولوجي يجعل التاريخ مشبعاً بالأفخاخ، التي يقع البحث فيها، لاستحالة التحليل فقط بواسطة اللغة. ومن أبرز الأمثلة وأوضحها، عندما يجعل منى شعوباً من العرب أثناء بحثه عن هوية شعوب العهد القديم كما تمرّ في التوراة. وليست المشكلة في استبعاد الأدوات الاثنوغرافية استبعاداً لا يمكن تفسيره بقدر ما أن الاستدلال إلى العروبة كان بحصر الترحال بالعرب وحدهم.
هذا الاستدلال لا يأخذ في الاعتبار خريطة المجتمعات في ذلك الوقت، خاصة العبرانيين الذين كانوا من أهل الترحال. والإشارة إلى العروبة من هذه الزوايا، في غاية السلبية، وإن كانت غير متأثرة بالدعاية الاستشراقية القوية، فهي تخرج البحث من التاريخ، باستبعاد أجزاء منه لمصلحة تأكيد الفرضيات عنوةً. يحدث هذا مثلاً في عرضه لمسألة المسادا وجبلها، التي تعدّ نموذجاً حقيقياً بالنسبة إلى جيل الرعيل المؤسّس للاستعمار الصهيوني في فلسطين، حين يشير إلى «استعارتها» من قِبل الحركة الصهيونية من التاريخ السحيق، حيث كانت مجرّد معركة أنهى فيها الرومان تمرّد اليهود. والاعتراف بالجبل كعامل أركيولوجي لا يمنع البحث من الغرق في التحليل الفيلولوجي. وقد يباغت البحث القراء أحياناً برفضه بعض المسلمات. من الانتقادات الكثيرة التي وجهت إلى البحث، من قبل مهتمّين بنقد التوراة، كان رفضه تسمية الساحليين الشاميين بالكنعانيين، لأنهم برأيه لم يطلقوا هذا الاسم على أنفسهم، بل كانوا يتكنون بأسماء مدنهم. وبالفعل، بمراجعة نص منى، يتّضح أنه بدلاً من تقديم بديل عن رفض الكنعانية كنعتٍ بدلالة إثنولوجية، يتفادى البحث أيّ شرح، ويكتفي بتقديم بديل شائع، ولا سيما أن جميع سكان الأرض يُنسبون إلى مدنهم. لكن هذا النسب لا يعفيهم من الأنساب والأوصاف الأخرى. تبعاً لهذا المنهج الذي يتسرّع في التحليل، كان الموريسكيون ليكونون أهل قشتالة والمدن الإسبانية الأخرى مثلاً!
ما هو مؤكّد، أن ما قام به الصليبي من جهد كبير ينسحب على عمل زياد منى. منى نفسه يقول إنه يرتكز إلى موضوعة الأستاذ الصليبي، أي أنه لا يطرح نقاشاً جديداً بل يحاول استكمال التشكيك الذي بدأ في القرنين التاسع عشر والعشرين بالشرح التقليدي للتوارة. أما انحسار البحث في الجغرافيا، حتى رغم صعوبة تحميله أبعاداً سياسية لقلة الدلائل التي توفرها اللغة كمنهج وحيد، فلا يسقط عنه صفة التميّز، والاعتراف لصاحبه بالجهد الطويل في محاولة تفنيد الأصول الجغرافية للكتاب وتفسيرها.
“الأخبار”