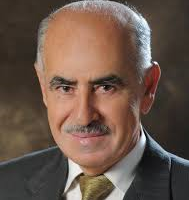ملحمة الحب والعطش(1) لسناء شعلان – د. رشيد برهون
يسكن الظمأ مجموعة “قافلة العطش”، ويتلبس العبارة والكلمة، ويصوغ المعنى وفق منطقه، منطق التشوف والتطلع إلى الآتي، أكان حلما واعدا، أو موضوع بحث مضن. إنه بالأحرى لا يبني المعنى ولكن يرسم ظلالا وإيحاءات، مستحثا القارئ أن يمارس لعبة تركيب الدلالة. ويكاد قارئ المجموعة، وقد استشعر حرقة الظمأ -سيد الفضاء- أن يلمس شفتيه، ويمرر لسانه عليهما، التماسا لقطرة ماء، بحثا عن الدلالة المتمنعة، المترائية بين سطور القصص، عطشا لا يرتوي، معنى لا يكتمل.. وقد جف الحلق، وانطلقت آلة التأويل عطشى تتحرق ظمأ للدلالة المستسرة في الظلال والإيحاءات والرموز. تقول المجموعة خيرني بين الماء والعطش، أختار الظمأ… خيرني بين المعنى الجاهز وعناء البحث عنه وبنائه، أنحاز لمتعة التماسه كلمة فكلمة، صورة فصورة. سئل باسكال الأديب الفرنسي صاحب “التأملات” أيهما يختار، الصيد أم الطريدة، فاختار القنص. ينفتح القنص على إمكانات الطرائد، كما يحيل العطش على قافلة من الدلالات غير المكتملة في المجموعة، وعلى القارئ أن يبني المعنى، التماسا لقطرة ماء، سعيا وراء نأمة دلالة.
يغدو العطش إذن استعارة كبرى ونواة دلالية ترتد إليها نصوص المجموعة، كما إنه يولد مرادفاته السياقية، متجاوزا معناه اللغوي الضيق، ليغتني في المستوى الرمزي، مكتسبا أبعادا وجودية ونفسية وفكرية عديدة. ويبدو أن أول قصة في المجموعة، تلك التي منحتها اسمها “قافلة العطش”، تنطوي على أبرز العناصر والمكونات المتفرقة في القصص الأخرى. يستوقفنا فيها أولا هذه الرحلة العجيبة نحو استرداد نساء مسبيات. وبلغة شعرية شفيفة، يجعلنا السارد -أو بالأحرى الساردة، كيف نتخلص من لغة الذكورة؟- نعيش مع القبيلة “التي أضنتها المهمة واستفزها العطش” مخاوفها وغضبها وسعيها إلى تخليص أسيراتها. غير أن الحب له منطق آخر، إنه منطق التمرد على الارتباطات الدموية والقبلية، والتعالي على الوشائج البيولوجية العرقية لمعانقة قيم أخرى. فالأسيرة ترفض الرجوع إلى أهلها، وتفضل العيش مع حبيبها الأسمر الذي “أرادها منذ أن رآها، كان عليه أن يفتض جمال الواحات، وأن يدرك أرض السراب قبل أن يفترشها، ولذلك أحبها، أحبها خيلا برية لا تدرك.. ” (ص. 10). لنلاحظ امتدادات العطش بالدلالات السابقة التي أشرنا إليها في عبارة “الخيل التي لا تدرك”، نحن دائما مع القنص لا الطريدة، مع معاناة البحث والسعي، لا الامتلاك والانتهاء في المملوك. فضلاً عما ترسمه هذه الصورة من علاقة إيروسية شبقية تشف عنها الكلمات، هي لغة القبول والصد، التباعد والتقارب، قبل الالتحام المؤجل إلى ما لا نهاية، إذ دونه العطش الذي يغدو هنا رديفا لرفض الماء والارتواء وإن أتيح… العطش امتداد نحو الممكن الذي لا يتحقق إلا ليصبح عطشا آخر… من الطبيعي إذن أن يستبد العطش بمتن النص في شكل عبارات ناضحة شعرا وظمأ: “ما أجمل الظمأ في بحرية العشق”(ص. 12)، لتكون النهاية نشيدا منتصرا للعطش: “كان مسموحا للقوافل أن تعطش وتعطش، ولها أن تموت إن أرادت، لكن الويل لمن يرتوي في سِفْر العطش الأكبر. ” (ص. 14).
ينتصر الحب على القبيلة، وتفضل الأسيرة سجانها على أهلها، لتأتي ببدعة “ما سمعت بها العرب من قبل، كيف تقبل حرة أن تكون في ظل آسرها؟”. إنه سؤال لن تتردد المسبية في الإجابة عليه: “أنا عطشى” (ص. 13). وينتصر الحب أيضا على رجال يخافون العطش الذي يهدد ارتباطاتهم ورؤاهم الضيقة: “عند أول واحة سرابية ذبح الرجال الكثير من نسائهم، اللواتي رأوا في عيونهن واحات عطشى، وعندما وصلوا إلى مضاربهم، وأدوا طفلاتهم الصغيرات؛ خوفا من أن يضعفن يوما أمام عطشهن” (ص. 13). تتلفع الحكاية هنا برداء الرمز، ومن الرمز ينشأ تفسير آخر للتاريخ الرسمي الذي كتبه الرجل: “العطش إلى الحب أورث الصحراء طقسا قاسيا من طقوسها الدامية، أورثها طقس وأد البنات، البعض قال إنهم يئدون بناتهم خوفا من العار، البعض الآخر قال إنهم يفعلون ذلك خوفا من الفقر، لكن الرمال كانت تعرف أنها مجبرة على ابتلاع ضحاياها الناعمة خوفا من أن ترتوي يوما” (ص. 13). وكما ينتصر العطش على القبيلة، يطوح أيضا بمؤسسة الزواج غير القائم على الحب، سيد الفضاء القصصي إلى جانب العطش، ورديفه في المجموعة. ففي قصة “النافذة العاشقة”، نجد أن الشخصية الرئيسة تحس بالترهل وانطفاء الأحلام “وبالتحديد منذ أن تزوجت رجلا لا يعرف من طقوس الرجولة إلا لحظات الفراش، التي تمر مثل التقاء غريبين في مرفأ عتيق، ثم سريعا يلوحان لبعضهما بالوداع دون أدنى مشاعر” (ص. 15). وعندما تريد التعريف بنفسها تقول إنها “متزوجة وأم لثلاثة أطفال وأسيرة لشيء اسمه زوج” (ص. 17). إلى أن تكتشف نافذتها العاشقة المطلة على الشاب ابن الجيران الذي يوقظ في نفسها العطش إلى الحياة. النافذة العاشقة هي إذن نافذة العطش، تسترد من خلالها المرأة إحساسها بذاتها، وبرونق عينيها وبنداوة بشرته، إنها نافذة “مدام بوفاري” في رواية غوستاف فلوبير الشهيرة، النافذة التي تستشرف من خلالها الحياة الموعودة. لا يتحقق اللقاء، ليظل العطش قائما، ولكن المرأة “كانت سعيدة… سعيدة… سعيدة جدا… ” (ص. 19). وفي قصة “تحقيق صحفي”، تجثو المرأة على ركبتيها بين يدي حبيبها لتقول له دون مواربة: “سيدي الطالب رجب، أنا أحبك، وأكره زوجي، طلقني منه، وزوجني منك. ” (ص. 72). والمنطق نفسه يطالعنا في قصة “احك لي حكاية”، فالشخصية الرئيسة لا تجد غضاضة في الإفصاح عن مشاعرها الحقيقية مخاطبة حبيبها: “هذا الجسد ينتظرك منذ تسعة أعوام، حتى ذلك الزوج لم يستطع احتلال هذا الجسد أو احتلال هذا الحب، لقد كان قدرا ساخرا لمدة تسعة أعوام، لقد كان زوجا في فراشي، ولكن ليس في روحي، لقد كنت في كل ليلة لك ومعك، كل ليلة تركت لك الباب مفتوحا، ليدخل طيفك الساحر، وليضمني بجنون” (ص. 81). لا تتردد القصص في التمرد على الزوج وقد أصبح شيئا، وعلى الزواج إذ غدا سجنا لأنه لا ينبني على الحب بل على الواجب والرتابة وتفريخ الأطفال. ذلك أن الحب في المجموعة هو موضوع دائم للعطش، لا يسلم منه أي كائن، يختلط بالعجائبي والسحري والواقعي، ويفرض منطقه على الجميع سيدا لا راد لكلمته. ففي قصة “رسالة إلى الإله”، تعبر الشخصية الرئيسة عن سخطها على الإله الأكبر زيوس لأنها “تريد أن تتحرر، تتمنى لحظة حب واحدة، أهذا كثير على إله السماء؟ أكثير أن تتمنى رجلا يحبها دون نساء الأرض؟ هي تشتهي مخاصرة حتى آخر العمر، لقد كفرت بإله السماء الأصم الذي لا يسمع شكواها” (ص. 20). لبى الاله زيوس طلبها، فخلق هاديس إله الموت الذي صمم على أخذها دون نساء الأرض. وهنا تتوالى صور العطش ملتحمة بصور يلتقي فيها الحب والموت واللذة: “جاء مسرعا وعطشان… امتدت يده السوداء القوية إلى تلابيب روحها، سكن ما بينها وما بين جسدها، ملأ ذاتها العطشى… كانت حشرجات الموت رائعة لذيذة… شعرت بسعادة العشق، وقبل أن ترحل مع هاديس إلى مملكة العطش، أرسلت زفرة شكر للإله زيوس” (ص. 22). وكما يأتي الحب مختلطا بالموت في “رسالة إلى الإله”، يحل حاملا معه الحياة في قصة “الفزاعة”، فبفضله تنبعث الروح في ذاك الكائن الفزاعة الذي لا ينتبه إليه أحد، بملابسه الرثة، وقبعته القديمة، وخروقها الكثيرة وقدماه الخشبيتين، وفمه المخاط على عجل، وجسده المصلوب ليل نهار، وقلبه المصنوع من القش، حسب الوصف الذي تقدمه القصة؛ ومع ذلك، فإنه لا يسلم من عدوى الحب، إلى حد أنه في نهاية القصة “استجاب لوجيب قلبه، ترجل عن مكانه، وقطع الحقل الصغير، داس دون أن يقصد بعض حبات الفراولة الحمراء، لم يقرع الباب، فتحه دون انتظار، ودخل إلى الكوخ” (ص. 30)، سعيا إلى مواساة الحبيبة الباكية. كل الكائنات في القصص ممسوسة بداء الحب، من الإله زيوس حتى الفزاعة، إنه الحب الذي يصنع المعجزات فيجعل الفزاعة يتمرد على شرطه المؤنث اسما، المذكر قلبا، الجامد وضعا، الحي باطنا.
يمتلك الحب أيضا في المجموعة فعل السحر، فهو يجمع بين المتناقضات والمتنافرات، ويوحد بينها: الطبيب الأشقر والساحرة الإفريقية في قصة “تيتا”، ؛ وعزوز الأعور والجنية في قصة “الرصد”؛ والوسيم الروماني والمرأة القزم المسخ في قصة “امرأة استثنائية”؛ والفنان وهاجر المجنونة في قصة “سبيل الحوريات”، وهنا يغرينا الوقوف عند الدلالة الرمزية البعيدة لهذا اللقاء بين الفن والجنون، في إشارة إلى النبع البدئي الأول لفعل الإبداع، وهو الجنون والتمرد وخرق المألوف. هكذا، بفضل التعطش إلى الحب، يلتقي البشر من كل الأعراق والألوان، ويتحد العقل والجنون، ويلتحم الإنس والجن، في أمكنة وفضاءات يختلط فيها الواقع بالأسطورة والخيال والحلم.
لا غرو إذن في ملحمة الحب والعطش هاته، أن تنتهي الكثير من الحكايات بأفعال تدل على البحث والترقب والظمأ: “الويل لمن يرتوي في سفر العطش الأكبر” (ص. 14)؛ “تنهد شوقا ورغبة، كان مجنونا مسحورا، وخمن أنه لن يشفى أبدا” (ص. 43)؛ “أقفل باب الكهف على الرصد” (ص. 48)، “طغى عليها صوت قطار منتصف الليل الذي غادر المحطة في رحلة جديدة” (ص. 61)، “ضاعت في الصحراء، ولم يعن أحد نفسه ليبحث عن امرأة عاشقة قد اختفت في الصحراء في مهمة صحفية” (ص. 73)؛ “سبحت في بحر عينيه، وهي تغالب الدموع، وقالت له احك لي حكاية” (ص. 85)؛ “في الطريق توقف لعشرات المرات، حدق في كل الوجوه والمناظر، وأدرك أن من نبحث عنهم هم دائما أمامنا وأن الحياة يصبح لها طعم آخر عندما نتوقف عند جزئياتها… ولو كان ذلك التوقف عند مواد قطة” (ص. 103)؛ “ومن جديد عاد يحترف الانتظار” (ص. 125).
يأتي في هذه النهايات/ البدايات رصد الآتي وتوقع حكايات ستنشأ من جوف الكهف رمزا لعمق المخيلة المولدة للحكايات، في تقابل بين المحطة والكهف بوصفهما فضاءين للامتداد نحو الأغوار المليئة أسرارا. ويغدو القطار والكهف رمزا للبحث عن عملية اقتناص حكايات أخرى تنسجها المصادفات ويستحثها الظمأ إلى الحب، كما إن فضاء الانتظار والأمام هو الأفق المشرع على الحكايات، ألم يقل غابرييل غارسيا ماركيز نعيش كي نحكي عما عشناه؟ تصبح الحياة إذن تعلة للكتابة عنها، هذا ما تقوله هذه القصص: الكهف والقطار وطلب مباشر لسرد حكاية ترويها لنا من جديد الأديبة سناء شعلان في مجموعة أخرى ننتظرها على أحر من العطش,
هوامش البحث
-
قراءة في المجموعة القصصية “قافلة العطش”، د. سناء شعلان، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2006.